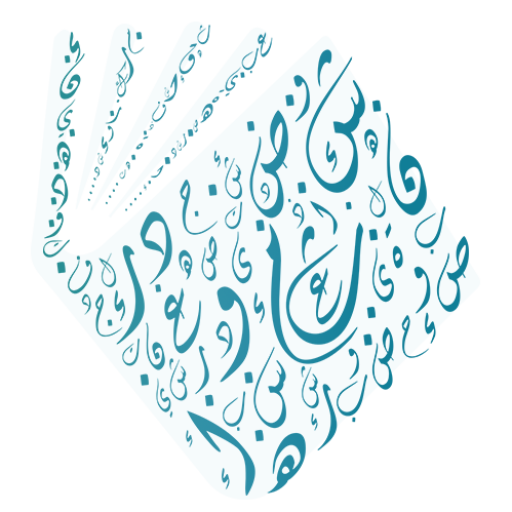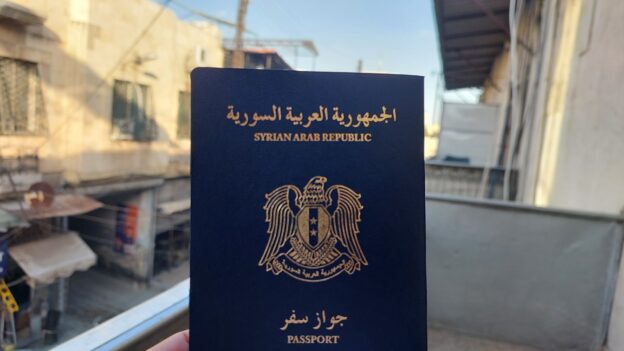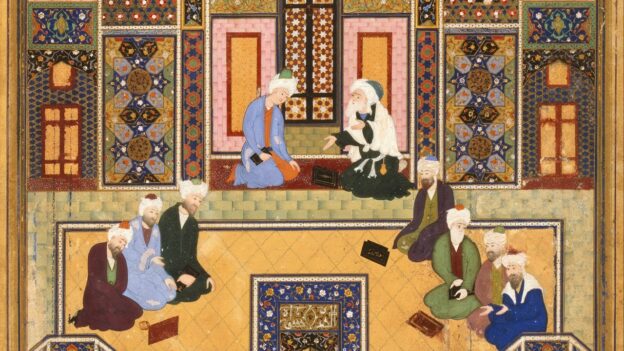[ المقالة ]
علاقة المعتزلة بآل البيت وتحالف الأقليات الفكرية
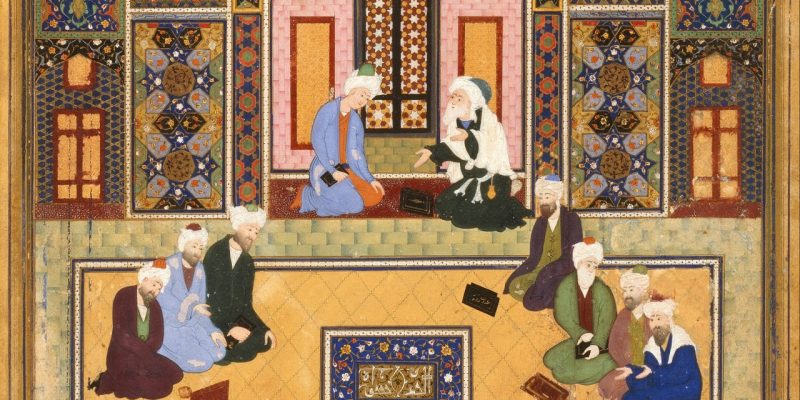
قبل أيام كنتُ في جامعة حلب ووقع نقاش بيني وبين أحد محاضري الفلسفة الكرام في الجامعة بحضور بعض الأساتذة الأفاضل.
عرض ذكرُ المعتزلة فقال الأستاذ الكريم ما معناه: (هم اتجاه سياسي احتج بالدين على بني أمية، وأن أصولهم الخمسة جاءت كتعبير عن رؤاهم السياسية، التي كانت متصلة ببني العباس).
قلت له: ما تذكره أنت وتدرسه لطلابنا هو منهج المستشرقين في قراءة التاريخ الإسلامي ومنهج الماركسيين في تحليل المجتمع، بل إن باحثا في قطر يدعي أن الاعتزال هو من صناعة آل البيت لمواجهة بني أمية. ولو فتّش وفتشوا قليلا لعلموا أن واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد لا يقبلان شهادة علي بن أبي طالب ولا خلافته ولا يقولان بإيمانه ونجاته بإطلاق، ويرونه هو ومعاوية وعثمان في استحقاق الفسق سواء فكيف يكونان واجهة لآل البيت؟ أو امتدادا لأبناء علي؟
طبعا لم يستمر النقاش طويلا لأنه تحوّل للحديث عن المساعد “أبو حيدر جوية” الذي كان يأتي إلى الجامعة فرتجف منه فرائص الدكاترة وترتعد القلوب، ثم نعمة التحرير والفرج الرباني ورجاء الدكتور أن يكتب للفاتحين أجرا وللمقيمين في مناطق النظام أجرين؛ أجر الثبات وأجر الخوف والجوع.
يا سادة بعد التحقيق والتمحيص نجد أن الاعتزال عبارة عن تحالف “أقليات فكرية” تجاوزت الكثير من خلافاتها الداخلية لتستقر في حوض كبير اسمه الاعتزال، ويشكل فرقة كبيرة بعد قرنين تقريبا من انطلاق مُشَكِّلاتِه الأولى. التي جاء أبو الحسن الخياط بعد قرنين من وجودها ليحكم بأثر رجعي عليها بقوله في الانتصار: (وليس يستحِقُّ أحدٌ منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، فإذا كَمُلت في الإنسان هذه الخصال الخمس؛ فهو معتزلي). وهو كلام إن طبق بأثر رجعي يخرج واصلا وعمروا عن كونهم معتزلة حقيقيين، إذ لم يكونا ممن يؤمن بالأصول الخمسة على الشكل الذي شاعت عليه لاحقا بين تحالف الأقليات الفكرية التي يجري الحديث عنها.
وسأسرد لكم هنا شيئا عن تحالف الأقليات الفكرية التي شكلت الاعتزال:
1- تيار واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وهو الذي انطلق من القول بالمنزلة بين المنزلتين، وينسب إليهما الشهرستاني شيئا من مبادئ أربعة من الأصول الخمسة.
2- تيار الجهمية: الذي نفى صفات الله عز وجل، ونفى الرؤية، ولكنه كان جبريا. والجهم بن صفوان كان أخذ التعطيل عن الجعد، وهو أخذه عن عن أبان بن سمعان عن طالوت ابن أخت لبيد عن لبيد بن الأعصم اليهودي وهو أخذ ذلك عن يهود اليمن، كما رُوِيَ.
3- تيار القدرية الذي يرى أن الإنسان يخلق أفعاله، واشتهر في قيادته معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وقد أخذ معبد القول بالقدر عن سوسن النصراني، وأبي يونس المجوسي أو اليهودي، – كما رُوِيَ – وكان رأيهما موافقا لنصارى دمشق الذين يرون الرأي نفسه ومنهم يوحنا صاحب الهرطقة المئة، وكان موافقا للمجوس الذين لا ينسبون لإله النور خلق الشر.
4- الخوارج: جزء من الخوارج الذين اعتدلوا مثل الإباضية وغيرهم، أثروا في الاعتزال وأثر بهم، خاصة في أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والمعتزلة من حيث الأصل هم أفراخ الخوارج والنسخة الناعمة منهم. ولهذا نجد في فترة تاريخية لاحقة لظهور المعتزلة تحالفا بين المعتزلة والإباضية.
5- الزيدية: قريب القرن الثالث الهجري بدأ يتشكل شيء من التحالف بين الزيدية الشيعة وبين المعتزلة، وقد وضع مؤرخوهم روايات تحاول ادعاء تتلمذ واصل على أبي هاشم بن محمد بن الحنفية وتتلمذ زيد على واصل وتدعي علاقة أصيلة بين آل البيت الزيدية والاعتزال من جهة المنشأ. وهي روايات مردودة، فقد كان كل من واصل وعمرو عدوا لآل البيت ولا يقبلون شهادة علي بن أبي طالب ولا يقولون بخلافته، ويرونه يستحق لقب فاسق كاستحقاق معاوية له، وأنه لا يحكم لأحدهما على الآخر. والزيدية من حيث المبدأ يشاركون وجهة الخوارج والمعتزلة في مسألة الحكم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولهذا التقوا معهم وتحالفوا لاحقا لدرجة تبني الاعتزال كاملا ضمن الزيدية.
6- الاتجاه المعتزلي السياسي السلطوي وفيه أمثال ثمامة بن الأشرس وابن أبي دؤاد، وكثير من القضاة والفقهاء الأحناف الذين مالوا إلى السلطة في اعتزالها وشاركوا في نكبة المحدثين أثناء فتنة خلق القرآن، وقد نُكِبوا في فترة لاحقة فيما عرف بفتنة المعتزلة.
7- الاتجاهات الفلسفية التي ظهرت ضمن مدرسة البصرة وبغداد المعتزليّتين وفيها أمثال: النظام وأبي الهذيل، والخياط والجبائي، والقاضي عبد الجبار، وهؤلاء الذين نضج الاعتزال على يدهم وظهرت صورته المعروفة اليوم، وإذا أطلق اسم معتزلة بمعناه التام فإن شيوخ هاتين المدرستين أهله.
إن قراءة تاريخ هذه الاتجاهات الفكرية والسياسية وما آلت إليه أحوالها توصلنا إلى نتيجة واضحة تخبرنا أن الاعتزال بدأ بواصل من قوله بالمنزلة بين المنزلتين، وتحوّل مع الأيام إلى حوض للأقليات الفكرية التي رفضت منهج “أهل السنة” الذين يفسرون القرآن بالفعل النبوي، بخلاف تحالف الأقليات الذي فسر القرآن وفق اجتهادات بعيدة عن السنة تعتمد على الاجتهاد الشخصي والمتغيرات الاجتماعية والسياسية وخليط من العلوم الموروثة عن أصحاب الديانات السابقة خاصة اليهودية والنصرانية والمجوسية. وقد التقى المعتزلة مع الساسة أحيانا فتحالفوا معهم ضد خصومهم من أهل السنة كما وقع زمن المأمون، ورأت الاتجاهات الثائرة الإباضية والزيدية في منهج المعتزلة حاملا فكريا لثوراتهم السياسية فتبنّوها كليا أو جزئيا.
رغم كل ما سبق فإن تحالف الأقليات الفكرية هذا بذل جهدا كبيرا للحفاظ على معالم الشريعة الإسلامية من زهد وعبادة وأخلاق ورفض للظلم والانحلال وإشاعة للعلم وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومواجهة المرجئة الذي شكلوا – إلى حد كبير – تيارا علمانيا مبكرا ضمن المسلمين، يرى الاكتفاء بالإيمان مع التحلل من الأحكام، كما هو حال علمانيي المسلمين اليوم.
للتوسع أكثر في قصة المعتزلة بإمكانكم متابعة الحلقة الخاصة بهم التي قدمتُها السنة الماضية ضمن دبلوم تاريخ الفرق الإسلامية على قناة مركز الثقافة العربية، ففيها شيئ من تفصيل ما ذكرت، ومواضيع أخرى تفيد الباحثين في الاعتزال والفرق.
رابط حلقة “المعتزلة : الآباء المؤسسون تطورهم وأصولهم الخمسة”: https://www.youtube.com/watch?v=HFM5o7tTBhU&t=8s