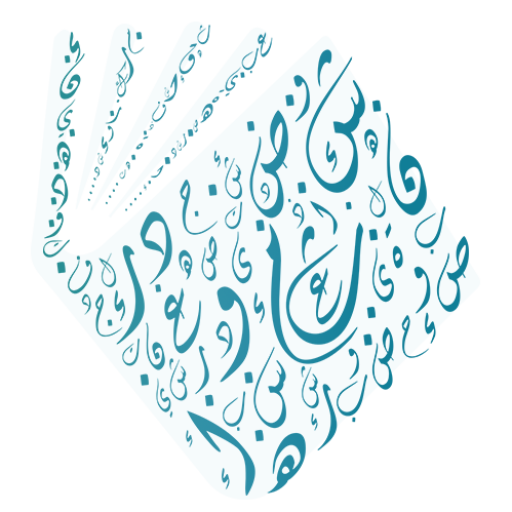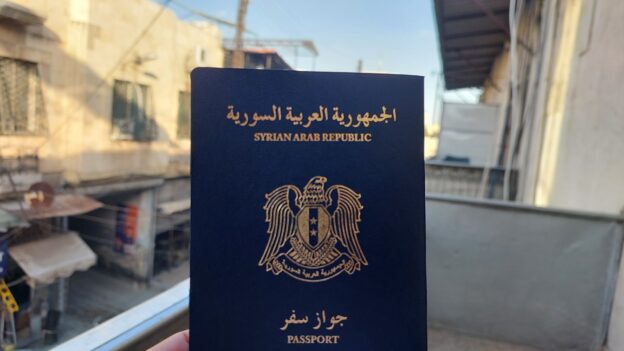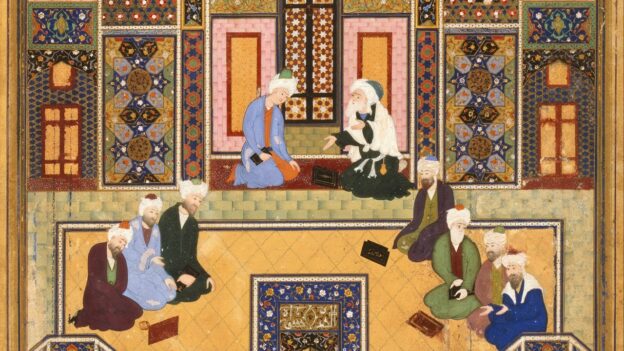[ المقالة ]
الدولة الدينية والمدنية! أو الدّولةُ المَرْضيَّة للهِ

لم ينقطع الجدل حول الدولة الدينية والمدنية منذ أطلّت الحداثة الغربية على العالم الإسلامي عموما وعلى العالم العربي خصوصا بنتاجها السياسي الذي خلف مرحلة ما بعد سقوط السلطنة العثمانية ونشأة الدول الوطنية والقومية والدويلات الصغيرة التي وُجدت نتيجة ظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية معقدة.
كل الإشكالات التي يناقشها المثقفون اليوم في مسألة الدولة الدينية والمدنية والعلمانية والإسلامية والسلفية والحداثية أو الدولة الممكنة والمستحيلة؛ تنتج عن استيرادنا لإشكالات الفكر السياسي الغربي أو تنتج كردّات فعل ضد الحداثة الغربية ونتاجها المادي والعلماني.
إن حلَّ هذه الإشكالات يكمن في عودتنا إلى ذاتية ثقافتنا الإسلامية والعربية، بما حوَته من مبادئ وقيم تصلح لكل زمان ومكان وبما أنتجته من آليات يمكن الاستفادة منها أو التعويض عنها أو استبدالها حسب المرحلة التي يمرّ بها الإنسان.
ولعلَّ أبرز مبدأين بإمكانهما حلّ إشكالات “صراع شكل الدولة” هما مبدأ الحرية ومبدأ الاستطاعة الّذَين نصَّ عليهما القرآن الكريم في آيات كثيرة. منها قول الله تعالى: ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ﴾ [يونس: 108]، ومنها قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286].
وبتدبر ما جاء في قصص الأنبياء في القرآن الكريم نجد أشكالا متنوعة لتطبيق هذين المبدأين في سلوك وتجارب جميع الأنبياء عليهم السلام المتمثل بقول نبي الله شعيب عليه السلام: {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}، والمتمثل أيضا بسلوك يوسف عليه السلام ضمن حكومة مصر التي كانت حكومة مشركة بغالبيتها، أو في سلوك النجاشي في الحبشة والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه والمسلمين في مكة قبل الفتح.
وقد قدم لنا النبي ﷺ في السيرة أشكالا متعددة من السلوك العملي لطريقة تنفيذ هذه المبادئ في كل مراحل حياته، منها نموذج التطبيق الذي كان في بداية الهجرة حينما كان سكّان المدينة المنورة خليطا من المسلمين واليهود والمشركين، فلم يكن نموذج الدولة الذي قدّمه النبي ﷺ غير مرضي لله، بل كان مرضيا لله وتشريعا منه ومن نبيه لأنه حقق المبادئ السياسية التي تنبثق من جوهر الدين السماوي، وهي فوق النَّسْخِ لأنها مبادئ وليست أحكاما، فقد تُنسخ الأحكام الشرعية الإجرائية، ولكن المبادئ والقيم لا تُنسخ كونها مرتبطة بجوهر عقيدة الدين الإلهي ومتفرعة عنها.
إن محدِّدات مبدأَي الحرية الدينية والسلوكية في القرآن الكريم والاستطاعة في الإصلاح ورعاية مصالح العباد وأحكام الإسلام تنبثق عنها قيم سياسية واقتصادية واجتماعية تمتد بآليات عمل تضبط عملية إقامة الدولة وتجعلها مرضية لله سواء كانت ضعيفة أو قوية، وسواء أشبه شكلها الخلافة الراشدة أو الدولة الحديثة. فلا أهمية لتصنيف الناس والمفكّرين والفقهاء للشكل النهائي للدولة طالما أن المبادئ والقيم التي ينطلق منها بُناةُ الدولة مرضية لله. أما الإجراءات والآليات فقد وسّع فيها الإسلام بشكل كبير مع قواعد لضبطها ليس هنا موضع نقاشها.
إن مراعاة المبادئ السياسية والقيم التي جاء بها الإسلام بحسب الاستطاعة وبما يضمن حقوق العباد وحريتهم – على اختلاف أديانهم أو طوائفهم أو أعراقهم – تحقق للإنسان رضى الله بغض النظر عن الإشكالات التي يطرحها دعاة الدولة الممكنة والمستحيلة والإسلامية والمدنية، إذ إن كثيرا من أطروحاتهم وأحكامهم تنطلق من ردود أفعال ورؤى محدودة وتتعلق بالأشكال وتغفل عن حقيقة جوهر الدين ومقصد إصلاح شؤون العباد على أي حال كانوا وفي أي بيئة عاشوا.
انطلاقا مما سبق فإن قاعدة الاستطاعة والحرية قد تؤدي إلى اختلاف النماذج الحكومية المنبثقة عنها لتكون أحيانا أقرب لما يسمى الدولة المدنية في الفكر الغربي وتكون في أحيان أخرى أقرب لما يسمى بالدولة الدينية عندهم، وهذا لا يهم، فالمهم أن يحصّل المسلم “الدولة المَرْضيَّة لله” التي تحقق مصالح الرعية على اختلاف أحوالهم وأديانهم بغض النظر عمّا يسميها الناس.
لهذا فإن المهم دينيا لكل الذين يبحثون عن رضى الله في العمل السياسي أن ينظروا في كل ما يقوم بمصالح الناس وحماية حقوقهم وخدمة الأوطان التي ائتمننا الله عليها وأمرنا بالرفق بها وتسخير مواردها لمصالح الناس دون إفساد، فيعملون به ضمن الاستطاعة بعيدا عن الجدل البيزنطي في الشكل النهائي للدولة والنموذج الذي تصل إليه.