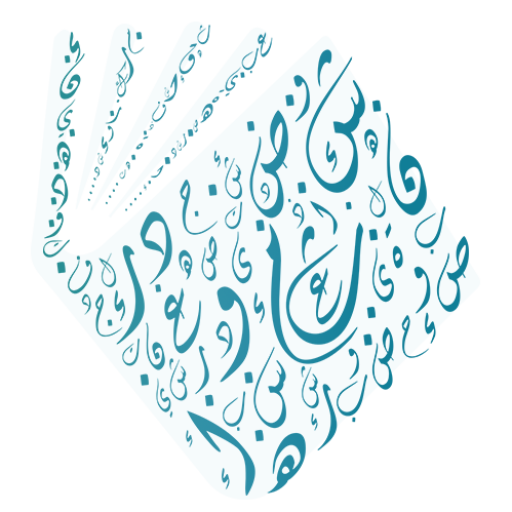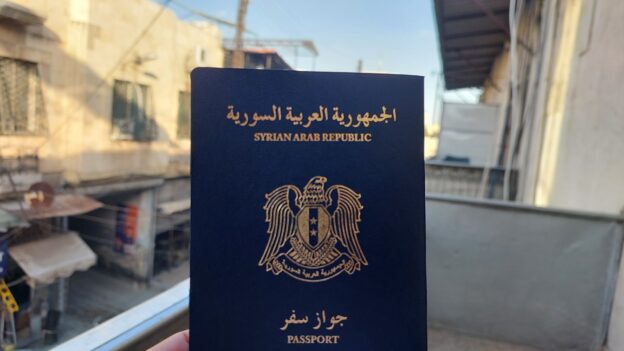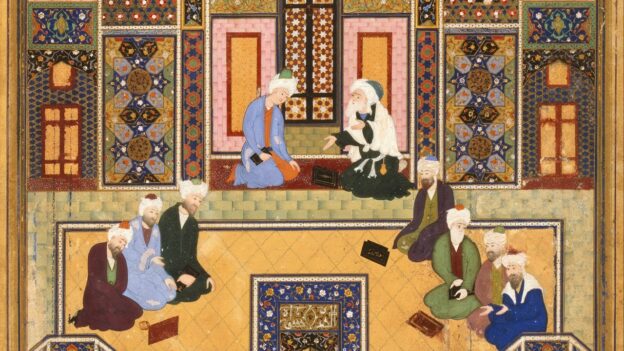[ المقالة ]
نحو التحرُّر من منطق الذهن المجرّد

يقول الأستاذ محمد المبارك رحمه الله في محاضرة ألقاها عام 1388هـ-1968م ونُشرت في بحث بعنوان “العقيدة في القرآن الكريم”: “والمنطق المجرّد قلّما ينفذ إلى أعماق النفوس، إذ لا بدّ له من عناصر أخرى تعينه وتزيّنه وتجعله مستساغًا مقبولًا، فدوافع العاطفة وإغراء الناس بما ينفعهم أو يلذّهم كلّها عناصر هامة مساعدة”.
وكلام الأستاذ المبارك رحمه الله هذا مهمّ جدّا، ولكنّي أرى أنّ بقية العناصر الزائدة عن المنطق المجرّد ليست مجرّد “عناصر مساعدة”، بل هي مادة أصيلة من مادة المنطق القرآني. فدوافع “الإرادة” وما ينفع الناس من جهة، والعاطفة والوجدان من جهة أخرى هي شيء أصيل لا يقلّ أهمّية عن “الذهن” (وهو أضيق من العقل بمفهومه القرآني الواسع). وكثيرا ما يتناول الدعاة أهمية الخطاب الوجداني من جهة كونه “معينا” و”مساعدا” وشأنا متعلّقًا بالأسلوب، لكنّ الواقع أنّه شأن متعلّق بالبنية العقلية للإنسان وبأهم دوافعه للإيمان.
وأودّ في هذه العجالة أن أنوّه إلى كتابات معاصرة ساهمت في ترسيخ فهم هذا الباب، وفي بيان مركزية “الوجدان” و”الإرادة” في الخطاب العقائدي.
حجج القرآن للفراهي
منها ما كتبه عبد الحميد الفراهي رحمه الله في كتابه المهم الذي لم يكتمل “حجج القرآن”، إذ بيّن أصالة “أوليات القلب” التي تسبق “أوليات العقل”، وخطأ الفلاسفة والمتكلّمين في وهمهم بأنّ الأصول العقلية أرسخ من الأصول القلبية، بل وضّح أنّ “الاختلاف في القضايا العقلية المستنبطة أكثر من الاختلاف في القضايا الأخلاقية”. وتحدّث عن “اليقين الضروري الفطري الذي لا يسع العقل أن يعصيه”، وأكّد على دور الذوق والإرادة والفعل في الترقّي في العلوم والمعارف، فالحواسّ “ليس فيها محض الإخبار بل لها لذّة وألم”، والنفس “بذوقها تحكم بكون الشيء مرغوبًا فيه أو مرغوبًا عنه”. فإنّ “الفكر والنظر من عمل النفس، ولا عمل إلا بإرادة، ولا إرادة إلا لرغبة، ولا رغبة إلا بذوق”.
وبصرف النظر عن اقتراب الفراهي بذلك من منهج من يُقدّمون “الإرادة” على “الفكر”، فإنّ طرحه في الباب يوضّح خطأ الاقتصار على مخاطبة الذهن في قضايا الإيمان، وتعطيل ذلك لمنفذ أساسي في النفس، فالذوق هنا ليس أمرًا “مساعدا” بل هو أساسي جدا.
المنطق الوجداني عند سيد قطب
ومن تلك الكتابات ما كتبه الأستاذ سيد قطب رحمه الله في فصل “المنطق الوجداني في القرآن” من كتابه “التصوير الفنّي في القرآن”، ثم طوّره وطبّقه في آخر ما كتب، وهو كتاب “مقومات التصور الإسلامي”، الذي صدر بعد عشرين سنة من وفاته، فهو يكشف عن دور الوجدان الأساسي في الاهتداء إلى حقائق الإيمان ويبيّن منهج القرآن في ذلك من خلال سياقات طويلة.
فقد بيّن الأستاذ سيد قطب في كتابه “التصوير الفنّي في القرآن” أنّ “أقرب الطُّرق إلى الضمير هو البداهة، وأقرب الطُّرق إلى الوجدان هو الحسّ. وما الذهن في هذا المجال إلا منفذ واحد من منافذ كثيرة، وليس هو على أيّة حال أوسع المنافذ ولا أصدقها ولا أقربها طريقًا”. ويحدّثنا عن طريقة القرآن فيقول إنّه عمدَ “دائمًا إلى لَمْس البداهة، وإيقاظ الإحساس، لينفذ منهما مباشرةً إلى البصيرة، ويتخطّاهما إلى الوجدان. وكانت مادّته هي المشاهد المحسوسة، والحوادث المنظورة، أو المشاهد المشخّصة، والمصائر المصوَّرَة. كما كانت مادّته هي الحقائق البديهية الخالدة، التي تتفتّح لها البصيرة المستنيرة، وتدركها الفطرة المستقيمة”.
وفي كتابه “مقوّمات التصور الإسلامي” يؤكّد على أهمية استجاشة الوجدان فيقول عن آيات كتاب الله: “وهي تواجه الكينونة البشرية بمشاهد وآثار تحمِل للعقل البشري ذاته براهين مقنعة، لأنّ فيها منطقًا صادقًا قويّا وواقعيّا. ولكنّها في الوقت ذاته لا تسلك إليه طريق الجدَل الذهني، ثم تتجاوز هذه المرتبة من مراتب الإقناع إلى تحريك الفطرة لتعمل؛ لتتلقّى وتلتقط، وتنفعل وتستجيب. ذلك أنّه بدون استحياء الفطرة، واستجاشتها للعمل، يظلّ البرهان العقلي معطَّلا لا فاعلية له. بل يظلّ البرهان الحسّي معطّلًا كذلك. كما يصوّر القرآن الكريم بعض النماذج الإنسانية المعطَّلة الفطرة، المطموسة الضمير:
{ولو نزّلنا عليك كتابًا في قرطاس، فلمسوه بأيديهم، لقال الذين كفروا: إنْ هذا إلا سحرٌ مبين}! (الأنعام: 7)”.
{ولو فتحنا عليهم بابًا من السماء فظلّوا فيه يعرجون. لقالوا: إنّما سُكّرتْ أبصارُنا، بل نحن قومٌ مسحورون}! (الحجر: 14-15).
وهذا هو الفارق الأصيل بين خطاب المنهج القرآني للكينونة البشرية بجملتها، خطاب استحياء واستجاشة، وتنبيه لأجهزة الاستقبال المعطَّلة أو المشلولة. وبين خطاب الفلسفة واللاهوت وعلم الكلام للذهن بالتصوّرات التجريدية أو بالجدَل البارد، الذي لا يصل إلى الإقناع المؤثّر المحيي للقلوب والعقول”. ا.ه
يحيى هاشم فرغل في “الأسس المنهجية لبناء العقيدة الإسلامية”
وهو كتاب قيّم غير مشهور في عصرنا هذا، كان رسالة الشيخ الأزهري يحيى هاشم فرغل رحمه الله للدكتوراه، وقد تحدّث فيه عن مفهوم مهم وهو: “الضرورة العملية”، التي هي أول الخطوات نحو الإيمان واليقين، بخلاف الطرح الكلامي الذي ينطلق من البديهيات العقلية أو “العلم الضروري”. وقد قسّم يحيى فرغل رحمه الله قوى النفس إلى قوة “الإرادة” و”العقل” و”الوجدان”، وكشف عن أهمية كل جانب بتأصيل علمي رصين، مع نقله لمختلف الآراء الكلامية القديمة والفلسفية الحديثة حول ثنائية الفكر والإرادة.
ومن لطيف ما قدّم في هذا الكتاب أنّه استقرأ القرآن استقراءً مجرّدا، لا بمنظار المنطق أو علم الكلام، فخرج إلى نتيجة مفادها أنّ نقطة البداية في الدعوة الإسلامية هي “الإنذار” وليست “إثبات الصانع” كما هو الحال في علم الكلام، وخلاصة منهجه الذي يعرضه ويستشهد له من كتاب الله عزّ وجلّ أنّ الإنسان يتعرّض بدايةً للإنذار بما سيكون بعد الموت، وهو ما يدفعه إلى ظنٍّ بصدق الرسول صلّى الله عليه وسلّم أو إلى التفكير بجدّية في مضمون رسالته، وأيّا كان فالأساس الذي يدفعه إلى ذلك هو “الضرورة العملية” بحسب تعبيره، وهي ليست فوق الظنّ، ثم يتعرّض الإنسان لعوامل تصديق الرسول صلّى الله عليه وسلّم، فيجد نفسه مُلجأً إلى التسليم بالحدّ الأدنى من الدلالة على صدقه أو بالدلالات المتنوّعة المتكاثرة، وينطق بالشهادتين فيكون مسلمًا. وحينئذٍ، يدخل في أول طريق تلقّي المعرفة الإلهية، من الله إلى الإنسان، صاعدًا بذلك من الظنّ إلى اليقين بهدى الله. وهو يرى أنّ العقل يحتاج إلى الإيمان بالله ولا يمكنه الاستقلال، ولا يصل إلى اليقين قبل الإيمان بالله. فخلاصة منهجه أنّ معرفة الله لا تكون إلّا من طريق الوحي.
خلاصة القول:
وخلاصة ما أريد الإشارة إليه في هذه المقالة الوجيزة أنّ الحديث عن “الوجدان” و”الجانب العملي” في كلام بعض الباحثين المعاصرين في مجال العقائد فيه غمطٌ ما لمحورية الجانب الوجداني والإرادي في الإنسان، فالأمر عندهم مجرّد “عوامل مساعدة” وليس جوانب أصيلة محورية في الكينونة الإنسانية. ومع إقرارنا بأنّ هؤلاء الباحثين قد تنبّهوا لأهمية هذا الباب، وحذّروا من قصور الخطاب العقائدي المنطقي الذي يرتكز على مخاطبة الذهن وحده، فإنّ مجال البحث في هذا الباب ما زال مفتوحا ليكشف عن محورية جوانب الإرادة والوجدان في خطابنا العقائدي، بل لا نبعد عن الحقّ حين نقول إنّ للقرآن منطقًا مختلفًا بشكل جذري عن المنطق الذهني الذي عَلِقتْ كثيرٌ من العلوم الإسلامية – بما في ذلك علم التوحيد – في شرنقته، وهو منطق رحبٌ يتّسع لجوانب الإرادة والوجدان تلك، وهو ما وضّحْتُه باستفاضة في كتابي الأخير “منطق القرآن: إصلاح العقل على طريق الحقّ والصدق والعدل”.