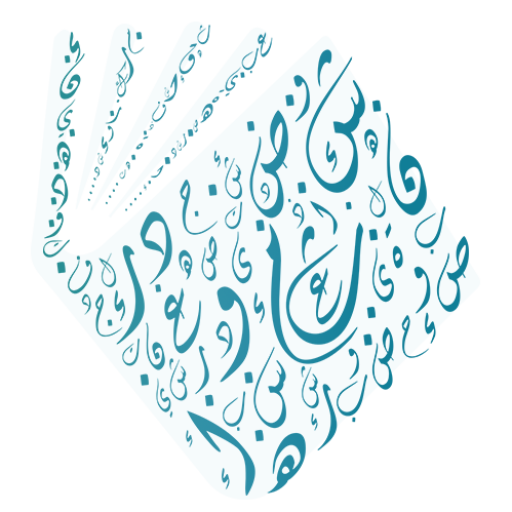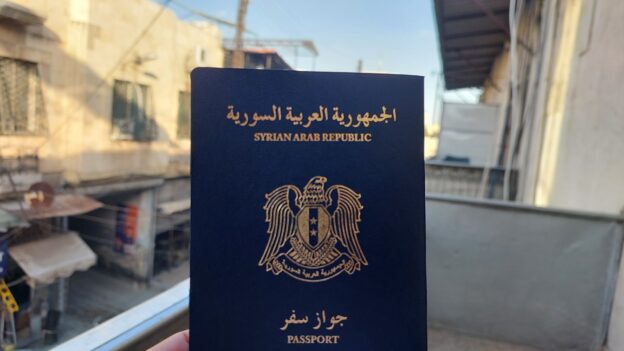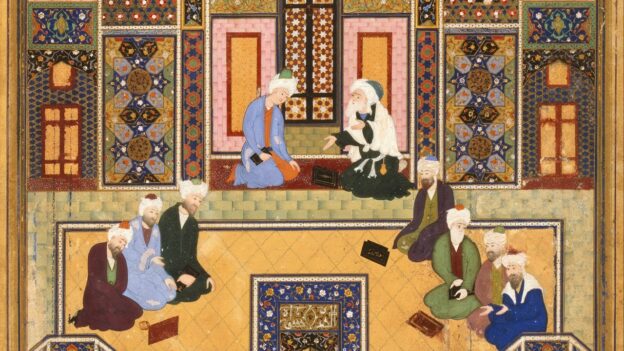[ المقالة ]
سطوة الكبار: نموذج في الحجب المعرفي
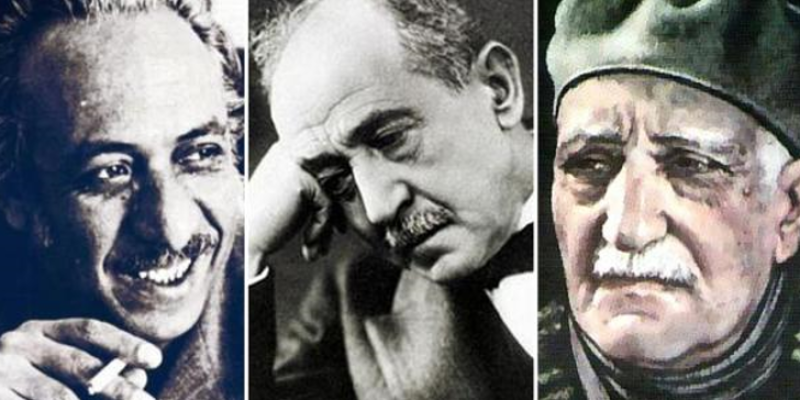
أحيانًا، كلمة من كاتبٍ في حقِّ كاتبٍ آخر، تتحولُ إلىٰ مُسَلَّمةٍ لدىٰ كثيرٍ من القرَّاء، ولسطوتها، لا نفكِّر حتىٰ بالاقترابِ من نتاجِ الكاتب وإرثه، إذ تظلُّ الكلمة تحومُ كلما فكَّرنا في القراءةِ له. والأخطر أنَّ الكلمة تتحول إلى صفةٍ ثابتة ملاصقةٍ للكتاب أو العَلَم، تجري عليها الأيَّام ولا تزيدها إلا رسوخًا، إذ تُؤخَذُ كأنها مروية لا تقبلُ النَّقد أو التَّفكيك وإعادة النَّظر.
وبعض هذه الإطلاقات كانت سببًا في الجنايةِ على حجب ما حقه الذُّيوع والاِنتشار والظُّهور، وصاحبها لا يُلام لأنَّه اِنطلقَ من قراءته الخاصَّة فأطلقَ حكمه الخاص، وانطباعه الذَّاتي، لكنَّ اللوم يقع على الرُّتبة التي يمثلها، فغالبًا من له تأثير علمي يؤخذ منه التَّقويم، أو الرَّأي، مأخذًا مغايرًا، لمكانته في سُلَّمِ العلوم، وصيته الكبير في دائرةِ المعرفةِ المشتغلِ بها.
وعمليَّة الحجْب من الأعلى للأدنى لم تكن ظاهرة معاصِرَة، بل لها جذور في التَّاريخ، وتمثيلات وقائعها لا حصرَ لها، فقد حاول النَّفر الأول من قريش حجبَ نور البيان الإلهيِّ الخالد بحكمٍ جائر، وتخرصاتٍ لا وجودَ لها، فكان الرَّجلُ يقدِم إلى مكَّة، فليقاهم، فيُلْقَى في روْعه من معاني التَّنفير والتَّرهيب ما يجعله يسدُّ أذنيه خوْفًا من مواجهةِ النَّص، كما حدث مع الطُّفيل بن عمرو الدوسي في قصته الشَّهيرة في صدر السِّيرة، وعندما هدمَ الطُّفيل جدران الحجب، وأقبل على النَّص بروحِ الباحث عنِ الحقيقة؛ وجَدَ النُّور قبالته.
في التُّراث الإسلامي، ثمَّة نماذج عديدة على هذه السَّطوة، لعلَّ من أشهرها، كلمة غامضة أُطلقت في حقِّ تفسيرٍ عظيم، تفسير الإمام الرَّازي -طيَّبَ الله ثراه– “التَّفسير الكبير: مفاتيحُ الغيب”، بأنَّه: «فيه كلّ شيءٍ إلا التَّفسير»، ثمَّ تأمَّل كيف ذاعت، وكأنَّها حقيقة لا تقبلُ النِّقاش؟ فما إن يُذكَر تفسير الفخْر حتىٰ تُستدعىٰ هذه المقولةِ الخاطِئة، وتلقي بظلالها القاتمة في رَوْعِك، فتحولُ بينكما! وعندما أعملَ أهل التَّحقيق مبضعهم في صُلبِ التَّفسير، أبانوا عن مكانته، وعلو منزلته، فقالوا: “فيه كل شيء مع التَّفسير”.
نماذج معاصرة:
وفي العصرِ الحديث، ظُلِمَ العقَّاد كثيرًا، بسببِ إشاعةٍ عابرةٍ بأنَّ لغته معقَّدة، ولهذا لا تعجب إن رأيتَ قارئًا نهمًا، لكن بينه وبينَ العقَّاد قطيعة، نمَت في لحظةِ فراغ! وقد أشاع هذه الإشاعة بعض تلاميذه، مثل أنيس منصور؛ الذي كان من أشدِّ المُذيعين هذه الفرية. ولو كانت للأرض آذان بها تتسمَّع؛ لصُدِّعت من كثرة ما أذاع أنيس أن العقَّاد صعب معقد، حتى صُمَّت. فما ترك كتابًا أو مقالًا أو حوارًا يستطيع فيه أن يشيع هذا إلا أشاعه. ومن بين الكتب الكثيرة التي عرض فيها أنيس دعواه، كتابه “في صالون العقاد كانت لنا أيَّام”؛ فقد بثَّ فيه ما وصفه “أول صدمة في حياته من العقاد”. يقول: “في أحد الأيَّام، كتبت مقالًا في جريدة الأساس سنة 1948. كان موضوعه: معنى الفن عند تولستوي. وصدر المقال يوم الجمعة -أيْ يوم الندوة الأدبية- (يقصد الأستاذ أنيس الندوة التي كان يقيمها العقاد أسبوعيًّا). وسألت الأستاذ إنْ كان قد قرأ المقال. قال: نعم يا مولانا، وأعجبني أسلوبه. انتهى كلام العقاد، وبدأ الكلام والآلام في أعماقي … أما المشكلة فهي أن الأستاذ قد أعجبه أسلوبي! وعدتُ إلى المقال أقرأه من جديد. لقد كان الأسلوب صعبًا مُعقَّدًا، أو هكذا تصورت. وكان مليئًا بالتراكيب الفلسفية … وحزنت على نفسي حزنًا شديدًا؛ لقد أعجب الأستاذ بأسلوبي، وأسلوب الأستاذ صعب، وأحيانًا معقد، وليس من السَّهل فهمه”([1]). ثمَّ جرت هذه الصِّفة على كل ما كبته العقَّاد، أذاعها كاتبٌ عن آخر، وأضحى مما يُعَيَّرُ به، كأنها صفةٌ تأبى الانفكاكَ عنه، تلقَّاها القارئ باستسلامٍ وقبول، وباتت من الحجُبِ الصَّادة عن تراثِ العقَّاد لدى كثيرٍ من القُرَّاء.
وما زلتُ أتذكَّر تأثير شيخنا الأديب الأثير علي الطنطاوي (ت: 1999) في توجهي القرائي في صباي، بسببِ انتقاده لبعضِ كتب مصطفى صادق الرَّافعي الأدبيَّة المشوبة بشيءٍ من التَّفلسف، مثل «أوراق الورد»، و«حديث القمر»، و«السحاب الأحمر»، ووجدتني أفرُّ منها زمنًا، ثمَّ أقبلتُ عليها بعدَ حين، فوجدتُ فنًّا من طرازٍ فاخر!
وللعلامة شيخ الإسلام مصطفى صبري (ت:1954) موقف حازمٌ في كتابه “موقف العقل والعلم والعالم من ربِّ العالمين وعباده المرسلين”، من العلامة محمَّد فريد وجدي (ت:1954) واستسخافِ بعض آرائِه وأقواله في كتابه “السِّيرة المحمَّدية في ضوءِ العلم والفلسفة”، وكانَ للأول سطوة العلم، فهو بقيَّة من بقايا الكبار، وكانَ لآرائِه ذيوعًا، وانتشارًا، ولها حظوة، ومكانة جُلَّى لدى القارئ، وكان لنقده الأثر الكبير في تحجيمِ كتابِ السِّيرة المحمَّدية ووضعه وصاحبه في دائرةِ الشُّبهة والاِتهام!
وكتَبَ العلامة محمود شاكر (ت:1997) كتابه ذائع الصِّيت “أباطيل وأسمار” في الرَّد على لويس عوض، وإلجامه، وكَسْرِ زَهْوِهِ، وقد طأطَأَ من إشرافِهِ، ورد إليه من سَامي طَرْفِهِ، فما تخرجُ من الكتابِ إلا وقد انهار لويس بينَ يديْك، فلا تفكر في العودةِ إليه، أو قراءة أي كتابٍ من كتبه، بسببِ التَّأثير المهول الذي يسكنكَ من وراءِ ما كتبه شاكر. وبعد مضيِّ السِّنين وقفتُ على السِّيرة الذَّاتية للويس عوض، فإذا بها سيرةٌ جليلة، متينة، ممتعة، لكنها حُجِبَت بسطوةِ اليراع الشَّاكري السَّامِق. وقد علَّقَ عليها الأديب عبد الله الهدلق، بقوله: “هذه سيرة مذهلة – وإن غضبَ علينا الشَّاكريون ! – وقد ندمتُ على أن أجَّرْتُ عقلي للعلامة الكبير محمود شاكر رحمه الله؛ فصدقتُ كل ما قاله عن جهل لويس عوض وتفاهته وتعالمه في كتابه «أباطيل وأسمار». نعم؛ لا أوافق لويس عوض على كثيرٍ من كتاباته، وقد أحسن العلامة محمود شاكر في فضحه وتعريته في الموضوع الذي رد عليه فيه، لكن من طالع سيرته الذاتية سيكره تلك الصورة التي رسمها شاكر عنه حتى جعله في تفاهة أصغر صحفي”.
وعلى ذكر الهدلق فقد وقعَ في سطوةِ الحجْب، ببثِّ آرائِهِ وانطباعاته (جمْلة) عن الأستاذِ المفكِّر مالك بن نبي – رحمه الله – (ت:1973)، وذلك بتَكرارِ القولِ عنه: “بيني وبين فكر مالك بن نبي نفرة فلا أحبُّ كتبه.. ولا آنسُ به، والكلمة التي تُنْسَب له كثيرًا «القابلية للاِستعمار» ليسَ هو أول من قال بها، هي لفرانز فانون”.
وتجدر الإشارةِ إلى ما تكلفه الدكاترة الأديب زكي مبارك من النَّقدِ المتعسِّف المجاوزِ لشريعةِ العدل، على عادته في مطاوعته عاطفتَه ومتابعته هواه، وخلطه الخصومة الشَّخصية بالنَّظر الموضوعي، إذ ذهبَ يطعن في بيان الأديب عبد العزيز البشري، ويزعم أنه أديبٌ يتصيَّدُ الأوابد من مجاهيل «القاموس» و «اللسان» و«الأساس»، وتلك حال المنشئين المبتدئين!
ويمضي في هجائه الذي زعمَ أنَّه نقدٌ خالص، فيصفه بأنه رجلٌ صخَّاب ضجَّاج، يدقُّ الأجراس الضخام حين يدخل الغابة للصيد، لم يفهم البلاغة على وجهها الصَّحيح، فكانت في ذهنه أجراس طنطنة وأصوات ضجيج، كل همه أن يفتنكَ في كل حرفٍ بأنَّ الكتابة شيء ضخمٌ فخمٌ يروعكَ ويهُولك وإن لم يكن لذلك موجبٌ توحيه الفكرة أو يفرضه البيان. ويتساءل: هل سمعتم بالرَّحى التي تطحنُ القرون؟ هي البشري في بعضِ نثره القعقاع!([2]). وقد صنعَ زكي مبارك صنيعه هذا مع ثلةٍ من الأدباء، والكتَّاب، قديمًا وحديثًا، فقد بايَنَهم، وقطعَ حبْلهم، وصرَمَ أسبابَهم، ومسيرته الأدبية لا تخلو من صراعٍ أدبيٍّ سجَّلته الكتب، وذاع خبره بينَ شداةِ الأدب([3]).
وفي كتابه: “ذكريات عمرٍ أكلته الحروف” يمارسُ الأستاذ الأديب نجيب المانع سطوته في حجبِ تراثِ بعض الأدباء الكبار، ومن قرأ ما كتبه عن بعضهم واقتنعَ به، فلن تمتدَّ يده إلى تراثهم، فما أبقى لهم شيئًا، يقول – مثلًا – عن الزِّيات صاحبُ الرسالة: “يذكرني بكتابات أحمد حسن الزيات المحمَّلة بفراغٍ قاتل لا تبحثُ عنه الشُّرطة؛ لأنه لا توجد شرطة معنية بقتل اللغة، وكنت قد وجدت أسلوب الزيَّات منذ زمنٍ طويل أسلوبًا لا يرحمُ في برودةِ دمه وثقله فابتعدتُ عنه كما يبتعدُ المرء عن انهيارٍ ثلجي إن اِستطاع”([4]). ولك أن تُنْعِمَ النَّظر في هذا القول عن أديبٍ طُلْعَة يعدُّ من روَّادِ الأدبِ المعاصِر، وعَلَمٌ شامخٌ مِنْ أعلامِ البيانِ، وإمامُ مدرسةٍ بيانيةٍ لا يزالُ يَنْهلُ مِنْ معينِهَا الصافي الكثيرونَ، مِمَّنْ يهتزونَ لروائعِ الأدب، وهو بقية مِنْ بقايا الكبارِ؛ أربابُ البيانِ المُشرقِ الخالِد، وحَسْبُه ما قيل فيه: «إنه أكْتبُ كُتَّابِ العصرِ الحديثِ، وأنه صاحبُ أعظمِ ديباجةٍ مشرقةٍ عرفها العصرُ، وأقوى أسلوبٍ تفصَّحَ به كاتبٌ، وأحكمُ سبكٍ سَارَ به قلم منشئ، وأسلمُ بناءٍ وضعه أديبٌ».
وكنت قد كتبتُ قبْلُ أنَّ مِنَ الكتبِ التي كانت في مكتبتي منذُ سنواتٍ طوال، ولم أقترب منها بسببِ تحاملي الشَّديد على مؤلفه قبل قراءته بسببِ تأثير السَّطوة التي حجبتني عنه؛ كتاب “أولاد حارتنا” للأديب نجيب محفوظ (ت:2006)، وبعد أَنْ ذهَبَت تلكَ الترسُّبَات، وهدأت العواصف، فَكَّرْتُ بقراءتِهِ، لأقفَ بنفسي على اللغطِ الذي تركه الكتاب بين ذامٍّ حدَّ التَّكفيرِ، ومادحٍ حدَّ التَّبجيل.
“ولعلَّ منشأ اغتيال الرواية المبكِّر بدأَ سياسيًّا، فقد ألفَ نجيب محفوظ روايته عام 1958 بعد انقطاعٍ دامَ خمس سنواتٍ عن الكتابة، وانتقلَ في روايته من الواقعيَّةِ إلى الرَّمزيَّة، وفي تلكم الأيَّام طلبَ من محمَّد حسنين هيكل نشرها في “مجلةِ الأهرام”، فقرأها “هيكل” قراءة سياسيَّة، ورأى أنها مثَّلت رموز النِّظام القائم في ذلكَ الوقت، لقد أدرك هذا جيدًا ونشرها في حلقاتٍ يومية، قبل أن يبدأ الهجوم على الرِّواية. وبسبب تلكَ القراءات السِّياسية تنبَّه جمال عبد الناصر وتدخَّلَ الأزهر الشَّريف ووضعت الرواية تحت المجهر، وكان اللغط قويًّا عليها، واتصل الرئيس ناصر بهيكل، وبعد طول جدلٍ ونقاش توصلا إلى تشكيل لجنةٍ من الأزهر لدراسة الرواية لتقول كلمة الفصل فيها، وقد كان”.
وقد نُقِلَ أنَّ النَّاقد اللبناني كرم ملحم كرم قال عن إلياس أبو شبكة في حياته: «لستُ أدري بعد كل ما أوضحت أي قيمة لشاعريته، إلا أن يكون شعر هذا النَّاسخ الماسخ لطخة في جبين الأدب.. ولو كان يملك في أدبه بعض الكرامة لاعتزل النَّاس وأسرع إلى صخرة الانتحار في رأس بيروت للنجاة من الخزي اللاحق به»([5]). وهذه دعوةٌ للانطفاء والصَّمت!
جماع القول:
لنترك لأنفسنا فرصة الاِكتشاف، والنَّظر في أُفقِ التَّوقع وانكساره عندَ القراءة، ومن ثمَّ الحكم عن قناعةٍ ذاتية، وليسَ بتأثيرٍ خارجيٍّ – له أسبابُه الخاصَّة – يحرمكَ من لذَّةِ التَّجرِبة، وتلمس الطَّريق!
وإذا أحببتَ أديبًا أو كاتبًا، لا يعني أن تُسيء إلى غيره، أو تزهد فيه، ولو كانَ الخلافُ بينهما واقعًا، فالحاذقُ من أخذَ الثَّمرة، ووقفَ على آثارهم، وتجاوزَ ما حقه التَّجاوز فيما كانَ بينهم، والمحرومُ من حُرِمَ مغانمَ الإجادة، والإفادة، والعطاء عندَ الآخر؛ بحجَّةِ الخصومة، ومخيالِ داحسِ والغبراء!
واعلم أنَّ ما سقته لكَ لا يعني إيقاف حركةِ النَّقد، “فالنَّاقد هو عينُ القارئ”، وهو القارئ للقارئ، “وهو الذي تسبقُ ساعته ساعة القارئ بخمسِ دقائق كما قال النَّاقد الفرنسي الكبير سانت بوف”. لكنَّ النَّقدَ شيءٌ والحكمُ الانطباعيُّ العام المبني على تغييبِ واغتيال عملٍ علميٍّ أو أدبيٍّ شيءٌ آخر، لا سيما إن صَدَر من رجلٍ ثقيلٍ تنهضُ له الأعناقُ، وتنحني له الرِّقاب، وكمْ جَنَت الأحكام القاطعة على نفائس دفنت وحقّها العيش فوق رؤوس القرَّاء.
([1]) في صالون العقاد كانت لنا أيام، أنيس منصور، صـ15،14 بتصرف، دار نهضة مصر، ط1، 2012. ويراجع مقال صديقنا الأستاذ عبد المنعم أديب في مِنصَّة حكمة يمانية: “هل كتب العقاد صعبة كما يشاع؟”.
([2]) ينظر: النضار الآثار الباقية لجاحظ العصر عبد العزيز البشري، د. عبد الرحمن قائد، آفاق المعرفة للنشر، 2023، ط1، ص21
([3]) وقد شهدَ القرنُ المنصرمُ معاركَ أدبية وفكريَّة؛ استحقَّتِ التَّدوين، بقيت أخبارها تتلىٰ في المجالسِ، والصُّحفِ السيَّارة، وكلُّ فريقٍ يشيدُ بمحاسنِ القلمِ الذي حسمَ المعركة، ويزري بالخصمِ الذي سُحِقَ بضربةِ الحرفِ القاصمة! وقد رَحلَ الفرسان الذينَ أشعلوها، وأذكوا نيرانها، وطوىٰ الزَّمان صفحةَ معاركهم، وبقيتْ معالمها، وآثارها، وشواهدها، وكذا تبْر معانيها الذي لم يُدفنْ بتعاقبِ الأزمنةِ والأيَّام، وما يميزها = الحصيلة الأدبيَّة، والفكرية التي صَدَرت عنها، وانسلت من رَحِمها، وكلما أمعَنَ القارئ النَّظر في معاركهم؛ تمنىٰ لو طالتْ واستطالت، ليسَ حبًّا في الخصومةِ ذاتها، وإنما ولهًا وحبًّ لمِنَحِها وغنائمها.
([4]) عمر أكلته الحروف، نجيب المانع، مؤسسة الانتشار العربي، 1999، ط1، ص75.
([5]) الغريب أنه قال عنه بعد مماته: «إني لأتعجب من النقيضين فيك؛ أيموت من يطعم الخلود زاد البقاء! أيذهب الموت بمن خلع على الدهر كساء لا يبلى، وألقى في فم الأجيال أناشيد تجاوز روعة أنغامها الأحقاب، طاب مثواك بطيب أعرافك»! وقد نقلتُ الخبر بينهما من الأديب عبد الله الهدلق في كتابه: “ظلال الأشياء”.