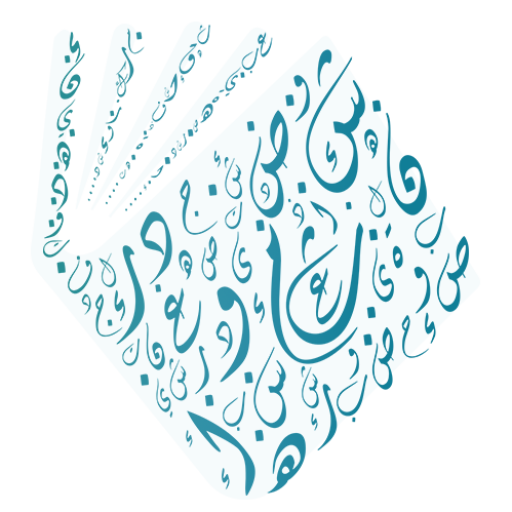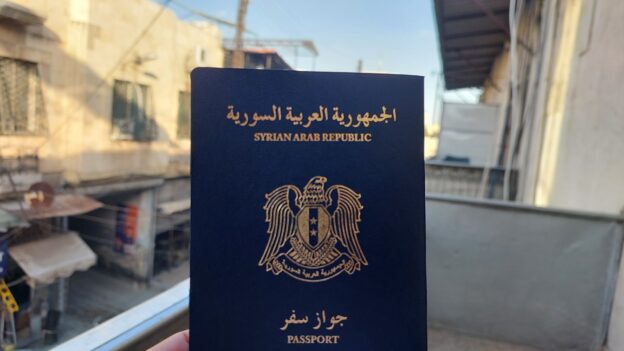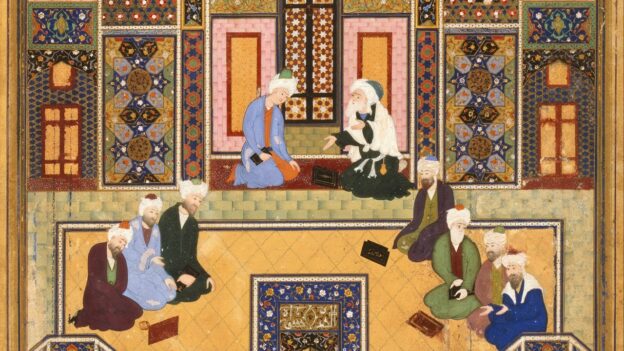[ المقالة ]
داعية القرآن – سيرة الشيخ فريد الأنصاري

قيل عنه إنه استطاع أن يشذب ويهذب بمقص القرآن بساتين الأرواح، فاهتزت لذلك أغصانها طربا لنسيم الرسالات، وظهرت لها العلامات، فكانت سابقة لغيرها، أسس مشروعه القرآني فأطلق عليه “من القرآن إلى العمران” واستطاعت كتبه ومحاضراته ودروسه أن تهدي الحائرين من الأمة إلى خطوات العمل الإسلامي المطلوب، والتشرف بالانضمام الى جموع بعثة التجديد المقبلة.
هو رجل تسبقه صورته، ولا يمكنك وأنت تقترب منه إلا أن تتوارى خلف الكلمات كي لا تخدش جمالها، فهي صورة ذات تجليات نورانية، لم يزل رحمه الله فارس زمانها، يرسم معالم حدائقها وردةً وردةً، ويهيئ أشواق الروح بكلماته زادا للأرواح المتشوقة باستمرار.
غادرنا منذ ما يقرب العقد ونصف العقد! لكن كلماته لا تزال تصدح عاليا في سماء الفكر والوجدان.
فمن يكون هذا الرجل؟
ولد فريد الأنصاري، بطل قصتنا هذه، في سنة (1960م)، لوالد نزح من منطقة “بحاير الأنصار” جنوب شرق المغرب، بواحات سجلماسة، في قرية أمازيغية تسمى (أنِّيف) ولأم أمازيغية اسمها عائشة مهاجر، وكان والده الحسن بن محمد بن حسن الضرير الفقيه بن محمد بن المكي القاضي خريج القرويين ومعلما فيه، أما أمه فقد كانت شديدة التدين لا تفتر عن العبادة والذكر، وتربت في حجر جدتها لأمها الأمازيغية التي غرست في ابنها فريد بذرة التدين، مما انعكس عليه بالخير؛ فشب وترعرع على الخلق والدين.
كان فريد في صغره كما يحكي ذلك عن نفسه في رواية “كشف المحجوب” يساعد والده خارج البيت في أمور الفلاحة وغيرها مما كان يقسو بها عليه أحيانًا، كما كان إلى جانب ذلك لا يفتر عن المطالعة من مكتبة أبيه، ولما دخل المدرسة الوحيدة في القرية أسقطه والده في مرحلة التعليم الابتدائي سنتين تشديدا منه عليه في التأهيل العلمي، فنظم نفسه ووزع وقته بين حفظ القرآن الكريم على يد فقيه الجامع، وقراءة أواخر الأذكار مع الفقراء بالزاوية، والذهاب الى المدرسة، ثم مساعدة أمه في أشغال البيت وإخوته في عمل الحقول، ولم يكد يكمل المرحلة الابتدائية من تعلمية حتى أتم قراءة كتاب “لسان العرب” لابن منظور بالكامل.
بدأت شخصية الأنصاري تتبلور وتتشكل بوضوح مع دخوله مرحلة التعليم الإعدادي والثانوي، فقد كان عليه أن يغادر البيت إلى بلدة (أرفود) القريبة، فأقام مدة من الزمن في بيت عمته، ومدة أخرى في السكن الداخلي التابع للمؤسسة التعليمية، فكان شغوفا بالقراءة في هذه الفترة، إذ لم يكن وهو عند عمته ليدع أي كتاب يضع عليه يده قبل أن يأتي على تمامه، وقد لفت ذلك نظر من حوله، حتى إن إحدى النساء قالت لعمة فريد يوما: غريب ابن أخيك، ليس كباقي أولادنا، لعله يريد أن يصبح عالما!
ثم بعد ذلك درس في المرحلة الثانوية في بلدة (كلميمة) إلى أن حصل منها على شهادة البكالوريا.
ومما يذكر عنه في هذه المرحلة أنه كان يخطو أولى خطواته في ميدان الدعوة إلى الله، ففي سنته الأولى من هذه الفترة الدراسية كان قد أقنع بعض زملائه التلاميذ بفكرة عقد (مجلس تربوي) داخل غرفة من غرف السكن الداخلي للمؤسسة التعليمية، وكان هو وإياهم في المجلس ينقلون ما استفادوه من خير إلى بقية التلاميذ، فكان مما أنجزوه جماعة مجلة تُكتب في دفتر يتداولونه بينهم، وكان هو صاحب فكرة المجلة والمشرف عليها، كما بدأ كتابة الشعر وأجاده، فأرسل في هذه الفترة قصيدة لإحدى المجلات المغربية، فلم تنشر له، وأجيب في ركن الردود: (نتمنى أن تكون هذه القصيدة لك) ، وكان ذلك علامة مستواه المتقدم جدا في الإنتاج الأدبي الذي خلف فيه أزيد من تسع دواوين شعرية وثلاث روايات ورابعة لا زالت مخطوطة.
انتقل فريد بعد ذلك إلى الجامعة في (ظهر المهراز) بفاس سنة 1981م، وهي السنة الثانية من تأسيس شعبة الدراسات الإسلامية، فاختارها مسلكا علميا له. وبدأ مرحلته الجامعية متشبعا بالفكر السلفي ومتأثرا بدعوة تقي الدين الهلالي وصداه رغم أن الطابع الغالب على محيطه العائلي كان ميالا إلى السلوك الصوفي، وفي هذه السنة ألقى أول درس له وكان الموضوع حول شخصية عمر بن الخطاب وقد ترك درسه فيه أثرا كبيرا.
استفاد فريد من تخصصه الشرعي واحتك بأجواء النقاش والحلقات الفكرية التي تعقدها المجموعات الطلابية بمختلف تلاوينها في الجامعة فعرفها وخبرها وشكل ذلك جزءا كبيرا من شخصيته، تأثر بعد ذلك في حياته العلمية والروحية بالدكتور الشاهد البوشيخي والذي كان له الأستاذ المربي والشيخ الروحي والعالم الفقيه والموجه الحكيم المشرف على أطروحته للدكتوراه والتي فتحت له أبواب التعرف على علم كبير هو أبو إسحاق الشاطبي، حتى صار من أعمق من استوعب نظرية المقاصد عنده.
وتعرف أيضا في فترة من فترات بحثه عن حقائق الإيمان على ابن القيم فخص دروسا من دروسه المسجدية بعد زمن لمنازل الإيمان انطلاقا من كتاب “مدارج السالكين ومنازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين”، كما تعرف أيضا على سعيد النورسي فخص رسائله بكتاب عنونه بـ”مفاتيح النور”، وبرواية عنه بعنوان “آخر الفرسان”.
وكان على طول انخراطه الفعلي في الدعوة والبحث العلمي وداخل الحركة الإسلامية خطيبا مفوها وداعية حكيما ورجلا متواضعا فأهله ذلك ليكون قياديا مسؤولا عن الشؤون الطلابية ومسؤولا عن الدعوة في وقت آخر- داخل صف الحركة الإسلامية- وبعد أن خرج منها، تولى رئاسة المجلس العلمي المحلي بمكناس فعقد أنشطة علمية كبيرة وألف كتبا شاهدة كانت له في بعضها كلمات انتقد فيها توجهه القديم -نقدا وليس نقضا- واشتد ذلك أكثر بإصدار كتاب الأخطاء الستة، فثارت ثائرة إخوانه فردوا على نقده بنقد جارح آلمه.
من سمات منهج الدكتور فريد:
وبالرغم من قلة انتقال الدكتور فريد الأنصاري -رحمه الله- بين المؤسسات خلال مسيرته المهنية، إلا أنه ترك بصمة لا تمحى، تشير إلى الجهد الكبير الذي بذله في إطار العمل الذي تولاه، فقد كان يتمتع بمكانة خاصة، ولم يكن موظفا عاديا، بل كان رائدا ذا همة عالية في خدمة العلوم الشرعية وإثراء البحوث العلمية. وقد أحدث تغييرا كبيرا في ميدان الدعوة الإسلامية من خلال المنابر التي شغلها في الجامعة وفي المجلس العلمي المحلي بمكناس، ويظهر أن فريدا بعد مراحل عدة مر بها في حياته باحثا عن النور اهتدى أخيرا إلى القرآن الكريم فحط رحاله عنده فألف فيه أكثر وأبرز كتبه، وخاصة “مجالس القرآن” الذي يقع في ثلاثة مجلدات، وهو كما يدل عنوانه: مدارسات في القرآن الكريم، تعرض مشروع «مجالس القرآن» بصورة عملية بهدف بيان منهج الاشتغال بكتاب الله، وكيفية إعادة بناء الأنفس على وزانه، ووفق مقاييس تصميمه؛ حيث يقدم من خلال بعض سور القرآن الكريم كيفية تلقِّي “الهدى المنهـاجي” الذي تتضمنه كل سورة. فهو بعبارة أخرى بيان عملي لما يرجى أن تسير عليه «مجالس القرآن» من تلقِّي رسالات الهدى بكتاب الله؛ عسى أن ينال الجلساء المتدارسون من بركات هذا القرآن خُلقًا ربانيًّا يجعلهم على هدى من ربهم في أمر الدين والدعوة تأسيًا بمن «كان خلقه القرآن»، عليه أفضل الصلاة والسلام.
يكاد يتفق كل من قابل الدكتور فريد الأنصاري وعرفه على دماثة أخلاقه وأدبه، وقد كساه ذلك هالة من الهيبة والوقار، جعلت أفئدة الناس ترنوا إليه، فكان عطوفا بهم، ألوفا عندهم، جوادا متواضعا لهم، صادقا تجد ما يكتبه قلمه هو ما يعبر عنه لسانه وحاله.
ولا يمكن لباحث عن الحق يعثر على الأنصاري إلا أن يجد أنسه في مجموع ما تركه من كتب، يمثل كل واحد منها نبراسا يبدد الظلام الحالك الذي يخيم على الصدور، ومصباحا يزيل الضباب الكثيف الذي يسكن العقول، خصوصا في هذا الزمان زمان الغيم والرؤية العسيرة.
فالفطرية، وبلاغ الرسالة القرآنية، وجمالية الدين، وقناديل الصلاة، ومفهوم العالمية، والتوحيد والوساطة، وسيماء المرأة في الإسلام، وأبجديات البحث، والبيان الدعوي، والأخطاء الستة، وغيرها مما ألفه مصابيح تنير طريق الحائرين، وهو فيها الفارس المغوار، والعالم المحنك، والباحث الكشاف، الذي جادت قريحته بدرر وكنوز علمية ولطائف ونكت بلاغية تأخذ بالألباب، ولعل ذلك ما يدفع من يكتشفه إلى النهل من ينبوع علمه الدفاق، والارتواء من فيوضات مشاهداته ومكاشفاته، فيستفد.
مرض الدكتور الأنصاري ووفاته:
ظل فريد الأنصاري في السنوات الأخيرة من حياته يصارع المرض في صبر وصمت، وجسد ذلك بما خطه في روايته التي كتبها على سرير علاجه في مستشفى سماء بإسطنبول، والتي عنونها ب”عودة الفرسان”، وكانت معاناته مع مرضه شديدة خلال الثلاث سنوات الأخيرة من حياته؛ أما بداية مرضه فكانت على يبدو سنة 2006م، حيث كان أول شعوره أنه يجد صعوبة في حمل الأشياء، إذ إنه لما يحمل برادا (إبريق) الشاي مثلا يجد بعض المشقة أو الألم في مفصل كفه (الكوع)، واعتقد بعض محبيه أن مناعته ضعيفة فأجرى تشخيصا لها وتبين أن الإشكال ليس فيها، وإنما يتعلق بمرض هشاشة العظام، ومن هنا بدأت رحلات علاجه.
وكابد الأنصاري المرض صابرا محتسبا، ولم يبخل على الدعوة إلى الله تعالى بوقت أحس فيه براحة عابرة، فكلما تحسنت ظروفه الصحية سارع خطاه إلى كرسي درسه أو منبره يخطب ويعظ ويعلم، وفي آخر محاضراته كانت الحروف تنساب من شفتيه بصعوبة… لكن مع ذلك كان يمضي قدما لإتمام الفائدة وإبلاغ الناس الخير، ويشهد بعض من عرفه أنه في آخر عمره كان إذا سئل عن حاله أجاب: حال خير من حال، إلى أن توفاه الله، فنهض الناس من مشارق الأرض ومغاربها أفواجا إلى جنازته، وقد ووري الثرى في 5 نونبر 2009م.
كان (رحمه الله) مصباحا من مصابيح الهدى، استقى نوره الرباني من شمس القرآن ونور جوامع كلم النبي ﷺ، فانساب نوره رقراقا، مشعِلًا قناديل أضاءت دروبا كثيرة، وأنارت مسالك عديدة، نفع الله بها خلقا كثيرا.