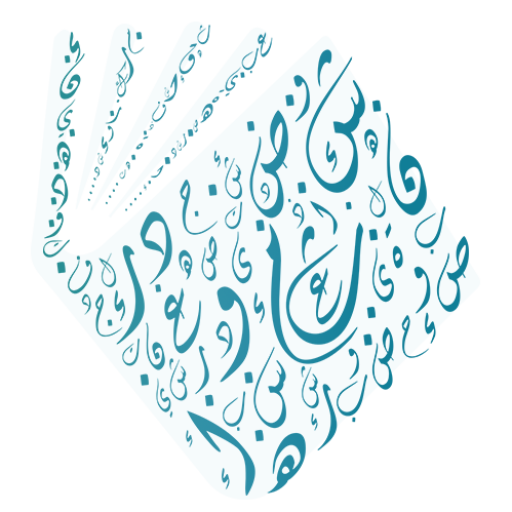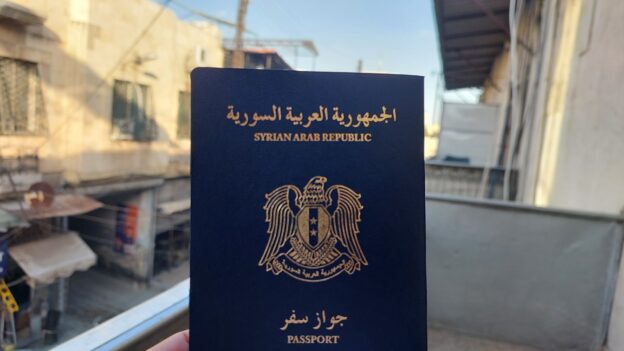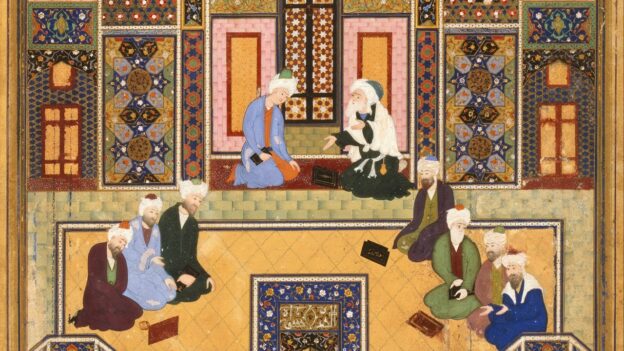[ المقالة ]
تطفيل البغدادي.. قراءة ثقافية مغايرة

اكتنزت سرديات تراثية كثيرة بأدب المقموعين، وانتشروا على صفحات كتب الأخبار والحكايات: حمقى ومتحامقين، ومغفلين، ومجانين، وطفيليين، وتم ترسيمهم في أسفل السلم الاجتماعي بصورة ساخرة تثير في المتلقي شهية الضحك، مع حرصه الشديد على إبقاء مسافة آمنة بينه وبينهم؛ هذه المسافة التي تليق بالعقلاء، وأصحاب الرياسة، والطبقات الاجتماعية الراقية. لكن ماذا لو كانت هذه السرديات مراوغة، تتقن التقنع والمخاتلة لتخفي في عباءتها حكاية مختلفة، ونكتشف في آخر المطاف أن هؤلاء المقموعين أصحاب رسالة فكرية اجتماعية، أرادوا تمريرها عبر الهزل، فتنقلب بذلك الموازين، ويغدو المقموع مفكرا متعاليا على المتلقي الذي ظن بنفسه الدراية، والسلطة التي تؤهله للحكم على الآخرين؟ إن هذه الزاوية في الرؤية تمنحنا حق المغامرة، وإعادة النظر في المكتوبات السردية والتاريخية، هذه المغامرة التي تؤمن بالنص ومعطياته، ولكنها تعيد تأويله وتفسيره.
من هذا الباب، صدّر الخطيب البغدادي (ت 463) في مؤلفه “التطفيل وحكايات الطفيليين، وأخبارهم، ونوادر كلامهم، وأشعارهم” سرديات التطفيل بوصفها أداة للهزل والإضحاك، وأدخل متلقيه فضاء الحكايات عبر هذه البوابة، الأمر الذي دعا الخطيب البغدادي، وهو من هو في مقام العلم والأدب، أن يعتذر عن خوضه في قصص هذه الفئة؛ فالاشتغال بغيرهم أحرى، والتوفر على قصص غيرهم أجدر وأولى، مما جعله يسوق في مقدمته تسويغين مركزيين لهذا الاشتغال الذي لا يؤمن به؛ أولهما: ضرورة إجابة سائله في التأليف عن أخبار الطفيليين إثر سماعه عن محاورة جرت بين أحدهم ونصر بن علي الجهضمي: “غير أني رأيت إسعافك بطلبتك، وإجابتك إلى مسألتك، من الأمور اللازمة، وأحد الحقوق الواجبة لتأكد حرمتك، وصفاء خلتك، وصدق مودتك”. وثانيها: التوسل بالترويح عن القلوب بمثل هذه الأخبار توصلا لراحة البدن والفكر، بغية إعادة الكرة في الاشتغال العلمي الرصين، فقد جمع البغدادي أخبار الطفيليين وساق أحوالهم لـ: “يستروح قلب العالم إليه من ثقل الجد، ويتروح خاطره بالنظر فيه من دوام الدرس والكد”، بل لقد أمعن البغدادي في الاعتذار عن الخوض في هذا الهزل العبثي بحشد سياقات شرعية وفكرية تسمح بتمرير اللهو لغايات التقوي على الجد، فعن الرسول الكريم: (يا حنظلة، ساعة وساعة). وغير ذلك الكثير.
استهل البغدادي سردياته بتفسير مادة (طفَل) لتوضيح ماهية الطفيلي، ذلك أن الطفل: إقبال الليل على النهار بظلمته، ويؤول ذلك بقوله: “وأرادوا أن أمره يظلم على القوم، فلا يدرون من دعاه ولا كيف دخل إليهم”. وفسر الأصمعي نسبة الطفيلي بالاقتران مع رجل من أهل الكوفة من غطفان، كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها، وكان يقال له طفيل الأعراس والعرائس، وقال في موضع آخر: “أول من طفّل الطفيل بن زلال”.
ثم قدم البغدادي صورة نسقية لشخصية الطفيلي، أظهرته بصورة “كاريكاتورية” محفزة للضحك، للمتلقي الداخلي للنص والخارجي على حد سواء، واحتج لذلك بأخبار كثيرة منها ما ورد في الخبر 117 : خرج قوم في سفر وتبنى كل واحد عملا، عرضه مستهلا بعبارة: “علي كذا”. ولما جاء الطفيلي قال: عليّ.. عليّ .. -مظهرا التردد- لعنة الله! فضحكوا منه وأعفوه النفقة. ومن ذلك تضخيم شراهة الطفيلي التي ندركها من خلال وصايا رؤسائهم الذين انطلقوا ينصحون الطفيليين بالأكل الذكي!: “افتحوا أفواهكم، وأقيموا أعناقكم، وأجيدوا اللف، وأشرعوا الأكف، ولا تمضغوا مضغ المتعللين، الشباع المتخمين”! لنرى التعجل وعدم التصبر التي تثير حفيظة المتلقي، وتدعوه للضحك من هذه الشراهة الاستثنائية! الأمر الذي يخلّق حالة من الإقصاء الاجتماعي لهذه الفئة المكروهة اجتماعيا، المنبوذة من مصاف المجتمع الراقي، ولذا صنف البغدادي بابا بعنوان: “فيمن ذم التطفيل وأصحابه، وهجا به غيره، وعابه، وقد جمع فيه من الصفات والتصرفات المرذولة التي لا يمكن أن تقبل اجتماعيا، فالطفيلي في هذا الباب:
- شره يأكل أكل شداد بن عاد.
- جاهل: لا يروي من الأشعار شيئا سوى بيت لأبرهة العبادي
- متعدٍّ على الآخرين: تأكل أرزاق بني آدم وأنت مخلوق بلا رزق
- هيّن على الناس، بل أهون من الذباب: أسرف في التطفيل من ذباب على طعام وعلى شراب!
الأمر الذي ولّد حالة نفور عامة من هذه الفئة، التي أتقن الكثيرون طردها وإبعادها: دخل طفيلي بيت صاحب عرس، فسأل عن هويته، فقال: أنا الذي قال فيّ الشاعر:
نزوركم لا نكافيكم بجفوتكم إن المحب إذا لم يستزر زارا!
فقال له صاحب البيت: زارا!! لا أدري ما هو !! قم اخرج من بيتنا.
الصورة المضادة للنسق
أطلقت الحكايات السابقة أصوات المتلقين بالضحك، وربما الشتائم ودعوات إبعادهم عن موائدهم وحياتهم، وعلينا هنا أن نتذكر أن منطق الهزل هو البوابة الكبرى التي أدخل البغدادي قارئه من خلالها؛ ليمارس بدوره تأويلات تؤول به للمتعة والتسرية عن الهموم، فهل تختزن هذه الصورة الساخرة في عباءتها بعدا آخر يثير في النفس شعورا مغايرا مستقبحا في حق المجتمع؟ ماذا لو نظرنا إلى هذه القصص من زاوية أخرى تقلب المرتكزات رأسا على عقب، ليكون المجتمع هو الفئة البخيلة الضالة، ويكون الطفيلي هو الفقير المقموع اجتماعيا، يحاول أن يأخذ حقه بصورة هزلية غير صدامية مع الآخر كما فعل الشطار والصعاليك المعروفون في العصر العباسي.
يمكن النظر للطفيليين على أنهم فقراء مهمشون، قال عثمان بن دراج وهو من كبار رجالات التطفيل: “مرت بي جنازة ومعي ابني، ومع الجنازة امرأة تبكيه وتقول: بك يذهبون إلى بيت لا فرش فيه ولا وطاء، ولا ضيافة ولا غطاء، ولا خبز فيه ولا ماء. فقال لي ابني: يا أبت، إلى بيتنا والله يذهبون بهذه الجنازة. فقلت له: وكيف ويلك؟ قال: لأن هذه صفة بيتنا!”. أمثال هذه الحكاية دعت حسين عطوان لتصنيف المطفلين في فئات الصعاليك الفقراء[1]، وكذا فعل حسن جعفر في موسوعة الشعراء الصعاليك، الذين قاموا بثورات اجتماعية لكنها مسالمة غير مسلحة: “إن معظم الثورات في العالم ذات منشأ اقتصادي، إذ ليس أصعب على المرء من أن يذل، ويسلب لقمة عيشه، وحقه في حياة حرة كريمة”[2]. وقد دلت إشارات كثيرة على هذا الفقر المدقع، على العدمية التي أفضت بالضرورة إلى ممارسة قصدية تريد أن تسترد الحق المسلوب بقوة البلاغة والتطفيل الذي كرهه المجتمع ولم يرغب به، وحاول إقصاءه بأدوات فكرية وشرعية وعملية. من أهم النصوص التي حولت مسار تفكيري بالتطفيل من بعده الهزلي النسقي إلى بعده الثوري، قول البزاز:
ولما رأيت الناس ضنوا بمالهم فلم يك فيهم من يهش إلى الفضل
ولم أر فيهم داعيا لابن فاقة يحن إلى شرب ويصبو إلى أكل
ركبت طفيليا وطوفت فيهم ولم أكترث للحلم والعلم والأصل
وانظر عزيزي القارئ في وصية ابن الدراج التي ساقها الحصري في زهر الآداب وثمر الألباب: “… فإنكم أحق بالطعام ممن دعي إليه، وأولى به ممن وضع له، فكونوا لوقته حافظين، وفي طلبه مستمرين، واذكروا قول أبي نواس:
لنخمس مال الله من كل فاجر وذي بطنة للطيبات أكول”.
والإشارة هنا واضحة في توالي مفردات حق الفقراء بطعام الأغنياء، ويتناص السرد مع أبي نواس الذي انطلق من منطلق شرعي وهو “خمس مال الله” الذي حق للفقير من الفاجر ذي البطنة، الممتنع عن أداء الزكاة والصدقة. إن هذا الحق الشرعي المسترد قوة وإكراها، يشفي السقم، ويجلي الغموم، إذ يحاول تأسيس شيء من التوازن الاجتماعي، يقر بذلك بُنان من أهم رجالات التطفيل، قال:
لذة التطفيل دومي وأقيمي لا تريمي
أنت تشفين سقامي وتجلين غمومي
يا صفي النفس يا خيـ ر جليس ونديم
قل إذا ما جئت قوما زائرا قول حكيم
قد أتيناكم بحسن الظــ ن والود القديم
ما تخاف الرد والحر مان إلا من لئيم
نحن قوم وهب اللـ ـه لنا فضل الحلوم
وهذا يدعونا للنظر العميق في التطفيل الذي نشأ بوصفه صناعة محترفة، هذا ما قالته السرديات: سأل رجل جماعة: ايش صناعتكم يا إخواني؟ قالوا: الطفيلية. ويرى بُنان أنه “ما في الدنيا أحسن من صنعتي”، وهي صنعة تحتاج الخفة والذكاء لتحقيق المآرب، ورد في وصية عثمان الخياط من كبار رجالات الصنعة: “ولا بد لصاحب هذه الصناعة من جرأة وحركة وفطنة..” ، ومؤلف التطفيل يكشف عن وجود تراتبية تنظيمية شغلت الهيكل العام لهذه الصناعة، فهناك مراتب لرجال التطفيل: الشيوخ، ومنهم الأستاذ، والعريف، والفتيان. وكانوا يلتزمون زيا خاصا بهم، فقد رئي شيوخهم يلبسون الطيالسة الزرق في الصيف، مما يوحي باتخاذهم زيا آخر في الشتاء. إذن، هي الصناعة التي تتغيا إنفاذ التوازن المجتمعي، وإعادة الحق لأصحابه، وتوفير الاعتبار اللازم للفقراء والمساكين بوصفهم مواطنين يستحقون الحياة الكريمة.
في بلاغة الإبلاغ .. تقنيات القول
نقل عن نيتشه قوله: “لما كان الإنسان هو أعمق الموجودات ألما، فقد كان لا بد من أن يخترع الضحك”[3]، بهذا المنطق يمكن قراءة المواطن المضحكة التي انفجر فيها متلقي التطفيل بالضحك، فالقصص الهزلية التي عرضها الخطيب البغدادي، صدرت عن أصحاب الصنعة، بصورة جيدة الحبك، والغاية منها توسيع مساحات الأنس والدعة وإن قامت على ألم المهمَّش المطفِّل الذي سيستثير الضحك، ويكافأ بالطعام، إنه التواطؤ الخفي بين الطرفين المتصارعين: أحدهما يحتاج انتزاع الحق، والآخر يهادن بروية درءا لإحراجه، وإثباتا لشيء من إنسانيته. قال برغسون: “فالضحك مهما نفترضه صريحا، إنما يخفي وراءه تفاهما، وأكاد أقول: تآمرا مع ضاحكين آخرين، حقيقيين أو خياليين”.[4]
في سياقات أخر يعمد الطفيلي إلى التسويغ الشرعي، ليؤطر تطفيله برؤية دينية تكفله، إنه يوظف التناص الديني، الذي يقيمه على تأويل ذاتي يخدم قضيته: يذكر بُنان بحديث الرسول الكريم: “من دخل إلى طعام من غير أن يُدعى إليه دخل لصا وخرج مغيرا”، فيرد الادّعاء المجتمعي عنه بقلب النص الشرعي لصالحه: “ما آكله إلا حلالا!.. أليس يقول صاحب الوليمة للخباز: زد في كل شيء، وإذا أراد أن يطعم منه قدّر لمئة وعشرين، فإنه يجيئنا من نريد ومن لا نريد، فأنا ممن لا يريد!”. كما يتعالق الطفيلي مع النص الديني منتزعا إياه من إطاره ومعناه، ليدخله في علاقة جديدة موظفة لتمرير إرادته في ظل منظومة مجتمعية لا ترغبه: نقش طفيلي على خاتمه: “فقال ألا تأكلون”! وادّعى بُنان بأنه حفظ القرآن كله ثم أُنساه إلا: “آتنا غداءنا”!
ويتكئ على الأجوبة المسكتة، وفيها لا يتلمس الطفيلي الحقيقة، بل يستند إليها لتحقيق وظيفة عرض الحال، والتخلص من إحراجات المساءلة المقيتة عن حضوره: سُئل ابن دراج وكان رأسه طويلا: مم؟ قال: “من مزاحمة الأبواب يعصرونه مع الحائط بالأبواب!”، ويعنَّف طفيلي لحضوره وليمة فيقال له: “قلت لك تجيء؟” فيرد: “قلت لي لا تجئ!!”.
وبعد،،
مارس النص الرسمي انحيازه، وسقطت كثير من نصوص التاريخ والأدبيات في مأزق هذه الأزمة الفكرية، التي نظرت للمهمشين من بؤرة الإدانة وزاوية الاتهام، الأمر الذي استتبع إنتاجا موازيا مقاربا يتبنى النظرة الأخرى، وينطلق من بيئة المهمش ذاته، تماما كما في إنتاج أدبيات الصعلكة، والشطارة، والتطفيل، ويحكم محمود إسماعيل على هذه الصورة بكونها الأشد التزاما بالموضوعية: “أبدع العوام ثقافة متميزة أكثر مصداقية، ذات بعد اجتماعي وإنساني، حيث تعالت على الصراع المذهبي، وتجاوزت الاختلافات الطائفية، والنزعات العرقية، كما تضمنت بعدا طبقيا مسكوتا عنه في الكتابات الرسمية، بما تحويه من ازدراء للطبقة الحاكمة، وسخرية من الطبقة الوسطى التي خانت دورها التاريخي، حيث تواطأت مع السلطة ضد العامة”.[5] ولعل هذه الإشارات العابرة التي أوّلت أوجاع الطفيليين، وجوعهم المجتمعي لحق الحياة والتآخي والحضور، عوض الغياب والإقصاء ما يدعو قراءنا أن يعيدوا النظر في مثل هذه السرديات، ويدمنوا طرح السؤال حيث حضر الحديث عن الطبقية، والتهميش، وتراتبية السلم الاجتماعي المقيتة التي ترفع أناسا وتخفض آخرين!
( [1]) الشعراء الصعاليك في العصر العباسي الأول، حسين عطوان.
( [2]) موسوعة الشعراء الصعاليك، حسن جعفر نور الدين، ج2.
( [3]) سيكولوجية الفكاهة والضحك، زكريا إبراهيم.
( [4]) الضحك، بحث في دلالة المضحك، هنري برغسون.
( [5]) ذهنيات العوام: بين المسكوت عنه واللامفكر فيه، محمود إسماعيل.