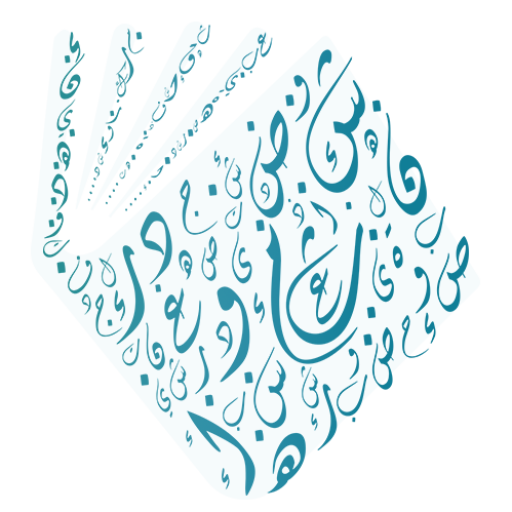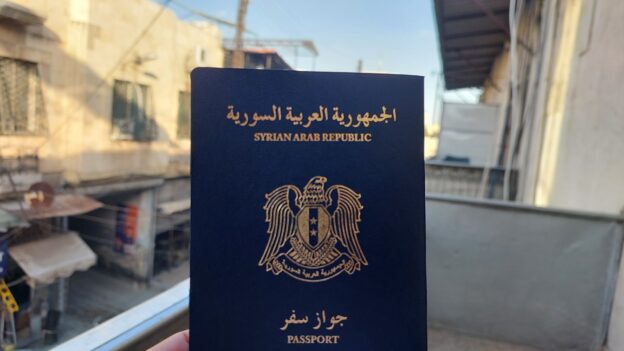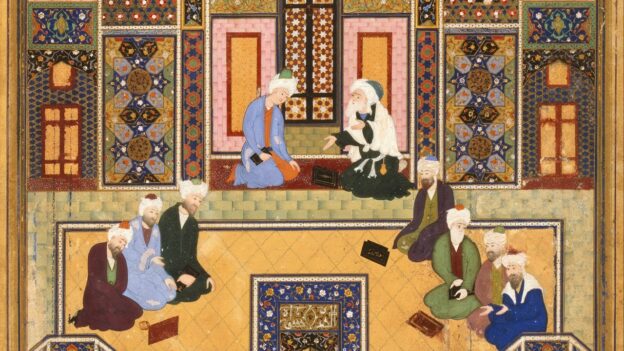[ المقالة ]
تاريخ التدين والإيمان

من المعلوم أن تاريخ الانسان هو تاريخ التدين والإيمان، وليس تاريخ الزندقة والإلحاد. هذه هي الخلاصة التي ينتهي إليها الناظر في تاريخ التدين عند الإنسان، والباحث في ينابيع النزعة الدينية في النفس الإنسانية. فقد وجدت في الماضي، وقد توجد في الحاضر أو المستقبل، كما يؤكد مؤرخو الأديان أمم بدون علوم أو معارف أو فنون، ولكن لم توجد قط أمة بغير دين. قال بعض هؤلاء المؤرخين: من الممكن أن توجد مدن بلا أسوار، وبلا ثروة، وبلا آداب، وبلا مسارح، ولكن لم ير إنسان قط مدينة بلا معبد، أو لا يمارس أهلها الصلاة.
ولكن الذي ينبغي التأكيد عليه هو أن تاريخ الإنسان إذا كان تاريخ الإيمان؛ فإنه لم يكن تاريخ الإيمان الحق أو الإيمان الصحيح. ومن أجل ذلك تتابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتعاقبوا، أي إن تتابعهم وتعاقبهم لم يكن من أجل إنشاء التصور الاعتقادي عند الانسان، أو من أجل زرع العقيدة في نفوس الناس، ولكن من أجل تصحيح عقيدتهم، وتعليمهم توحيد الألوهية والربوبية جميعاً، من وجه، ووضعهم أمام مسؤولياتهم في اليوم الآخر من وجه آخر.
قلنا: إن تاريخ الإنسان هو تاريخ الإيمان، وليس تاريخ الإلحاد، والذي نضيفه هنا: أن ذلك لم يمنع من وجود نزوع إلى الإلحاد عند بعض الأفراد في جميع العصور، أو في بعض المجتمعات في بعض العصور. والواقع أن الإلحاد لم يشكل تياراً إلا في بعض الأوقات لأسباب عارضة ترجع في أغلب الأحيان إلى الجهل أو الغرور، سواء أكان هذا الغرور بنوع من القوة، أو بشيء من العلم.
يضاف إلى ذلك أن هذا التيار على ضعفه وعدم قدرته على الاستمرار؛ لا يمكن فهمه أو تفسيره بعيداً عن المجتمع الذي وجد فيه، والبيئة التي ظهر فيها وما يسودها من قيم واعتبارات دينية مغلوطة، ولهذا قال بعض الباحثين: إن الإلحاد ينبعث من العقائد التي تصادم الفطرة، وتعارض العقل، وتخالف العلم أو طبائع الأشياء!
ومن هنا فإننا نلاحظ أن الإلحاد لم يشكل تياراً في أي عصر من عصور الحضارة الإسلامية، فضلاً عن أنه لم يكن من لوازم أو معالم عصر النهضة في الاسلام -الذي بلغ ذروته في القرن الرابع الهجري- وإنما جاء على لسان بعض الأفراد، والتصق لذلك بأسمائهم! فقالوا: «ابن الراوندي الملحد» وعدوا ممن رمي بالزندقة مع ابن الراوندي هذا عبد الله بن المقفع، وحماد عجرد، وبشار بن برد. وليس كذلك الحال في المجتمع الأوروبي في القرن الثامن عشر -عصر فولتير- الذي عرف عندهم بعصر الإلحاد! بل يمكننا القول إن الإلحاد كان يمثل في الأسماء السابقة في التاريخ الإسلامي خروجاً على عصر النهضة في الإسلام، ومحاولة لتشويهه ومناقضته وتعويقه أو القضاء عليه، على عكس التاريخ الأوروبي، الأمر الذي يدل على مدى ارتباط الزندقة بالشعوبية في تاريخ الحضارة الإسلامية.
الإلحاد ومناقضته للفطرة الإنسانية
يمكن تعريف الإلحاد بأنه إنكار لوجود الله تعالى، وبأنه ضد الإيمان، فإذا كانت حقيقة الإيمان تتمثل في الاعتقاد بالله واليوم الآخر -طرفا الإيمان أو ركناه الرئيسان- فإن الإلحاد يقوم بالمقابل على الجحود بالله، وعدم الإيمان بالخلود. أو هو بكلمة واحدة: يقوم على إنكار الغيب الميتافيزيقا أو ما وراء الطبيعة. ولهذا ارتبط الإلحاد بالقول إن سبب الكون يتضمنه الكون في ذاته، وارتبط بالفلسفة المادية والنظرة المادية إلى الكون والحياة والإنسان.
والإلحاد يناقض الفطرة الإنسانية مناقضة حادة! لأن نوازع الإيمان أصيلة في النفس الإنسانية وليست عارضة، أو بعبارة أخرى: هي جزء من خلق الإنسان وتكوينه، وليست من صنع المجتمع أو التاريخ، ولهذا فإن الإنسان لو خُلّي وشأنه لاختار الإيمان. ولا شك في أن الإنسان من حيث هو مخلوق فيه دلالة على الخالق جل وعلا، قال النبي ﷺ: «كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه». ولم يقل النبي: «أو يُسلمانه» لأن الإيمان بالله الواحد الأحد -جل وعلا- هو دلالة الفطرة والخلق الإلهي.
ولهذا كان ما يناقض هذه الفطرة من الإلحاد أو الشرك، هو الذي يأتي من البيئة والقدوة والمجتمع، ومن التعليم الذي يشوّه هذه الفطرة، أو يطمسها ويرين عليها -ويمثل ذلك كله الأبوان بوجه خاص، أو في هذه المرحلة المبكرة- قال الله تعالى: ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ [المطففين: 14]، ولكنه في جميع الأحوال لا يفسد «طبيعتها» أو خلقها، بحيث لا تستجيب للهداية، أو لا تعود إلى دلالتها الإيمانية التوحيدية مرة أخرى، ولهذا قوبلت «التزكية» في قوله تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (٧) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (٨) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (٩) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا﴾ [الشمس: 7-10] بالتدسية، أي التغطية والرين! ولم تقابل بالهبوط أو النزول، فضلاً عن المسخ، أو التحوير والتبديل، وعلى هذا فالفطرة ليست حيادية، ولكنها إلى الإيمان بالله تعالى أقرب. والإلحاد ليس عقلاً أو علماً أو منزعاً إنسانياً، ولكنه تكلّف ومناقضة وتشويه! فإذا لاحظنا أن النبي ﷺ لم يقل كذلك: «أو يُلحدانه» أو يُزندقانه مثلاً! أدركنا كذلك أن هذه المناقضة لا تبلغ في الغالب أو عبر العصور الإنسانية بعامة حد الخروج عن الدين، أو إلى ساحة لا يكون فيها الإنسان بغير دین، ولكن سوف يخرج به المجتمع أو التعليم إلى عقيدة فاسدة، أو مذهب محرف أو دين مدخول!
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾
وتأتي الآية التالية محكمة الدلالة على هذه النقطة، وعلى ما تجب الإشارة إليه في باب الفطرة والتدين بوجه عام، قال تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الروم: 30].
- فقد أمر الله تعالى نبيه ﷺ وكل مكلف من بعده بإقامة وجهه للدين، أي بأن يتجه ويلتفت تلقاء الدين ونحوه، وإقامة الوجه -كما يقول المفسرون- هو تقويم المعتقد، والقوة على الجد في أعمال الدين. وذكر الوجه لأنه جامع حواس الإنسان، ولأن إقامة الوجه إنما تعني في الحقيقة: القصد والتوجه، بل إن كلمة التوجه إنما جاءت من انصراف الإنسان بوجهه نحو الشيء! عليك إذن بالدين، فانصرف إليه، وتوجه نحوه! والسؤال الآن: لماذا الدين؟ والجواب: لأن هذه النزعة أصيلة وخالدة في النفس الإنسانية، ولأن في تلبيتها تلبية لتطلع إنساني، يقول الأستاذ عباس محمود العقاد رحمه الله: وفي الطبع الإنساني جوع إلى الدين كجوع المعدة إلى الطعام. والإنسان الذي يرفض فكرة الدين كالمعدة التي ترفض الطعام الجيد لا بسبب رداءة الطعام، ولكن بسبب ضعف المعدة.
ويقول أيضاً: إذا كان البعض ينكر فكرة الدين والعقيدة، ويتجاهل أهميتها، فإن ذلك لا يعود إلى رداءة العقيدة أو الاعتقاد، وإنما يعود إلى ضعف التكوين العقلي فيه أي أن الأمر من باب الشذوذ والاستثناء، أو من باب الضعف الطارئ -أو الإضعاف- بسبب المرض الذي لحق بالإنسان من جراثيم الشبهات والشكوك الخارجية أو الطارئة والتي يمكنه لذلك -كما أشرنا- أن يتعافى منها في يوم من الأيام.
ويقول الفيلسوف آرنست رينان: «إنه من الممكن أن يضمحل كل شيء نحبّه، وأن تبطل حرية استعمال العقل والعلم والصناعة، ولكن يستحيل أن ينمحي التدين، بل سيبقى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادي -الإلحاد- الذي يريد أن يحصر الفكر الإنساني في المضايق الدنيئة للحياة الأرضية». وجاء في معجم لاروس للقرن العشرين «إن الغريزة الدينية مشتركة بين جميع الأجناس البشرية، حتى أكثرها همجية وأقربها إلى الحياة الحيوانية، وإن الاهتمام بالمعنى الإلهي وبما فوق الطبيعة هو إحدى النزعات العالمية الخالدة للإنسانية».
قلت: فإذا كان الدين كذلك، فلا بد من طلبه والتوجه إليه، ولا بد من التسليم معه بأن الإلحاد واحد من الشرور أو من الأمراض الطارئة على النفس الإنسانية، وأنه ليس من طبيعتها ولا متأصلاً فيها، أو بعبارة أدق: ليس من طبيعتها حين تبقى هذه الطبيعة على حالة الصحة والاستقامة والاعتدال!
- أما الحنيفية، فيراد بها في الآية -ثانياً- الميل عن جميع الأديان المعوجة أو الباطلة -التي وقع أصحابها في الشرك أو عبادة الأوثان- إلى الدين الحق دين التوحيد. لأن الحنيف مأخوذ من الحنف، وهو الميل، أي عليك أن تختار، وأنت تتجه نحو الدين، دين التوحيد مائلاً عن كل ما عداه! كما فعل إبراهيم عليه السلام حين توجه إلى فاطر السموات والأرض، ورفض ما كان عليه قومه من الشرك وعبادة الأصنام، حتى إن بعض المفسرين ذهب في تفسير الحنيف مباشرة إلى أنه دين إبراهيم لأنه عليه السلام لم يكن يهودياً ولا نصرانياً، وكان لا يعبد إلا الله تعالى، وقيل: الحنف في اللغة: الاستقامة -فهو من الأضداد- قالوا: والحنيف في الدين: المستقيم على التوحيد، وعلى جميع طاعات الله عز وجل. ويبدو أن المعنى أو التفسير الأول أرجح ، وإن كانت النتيجة واحدة أو متفقة في نهاية المطاف.
- ثم توضح الآية -ثالثاً- أن هذا الدين المطلوب هو الفطرة في الواقع وحقيقة الأمر، لأنها -أي الفطرة- جاءت في الآية في موضع الدين، وفي معنى المبدل منه، والحال محله؛ ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ ﴾ أي دين الله، وإن كانت كلمة «فطرة» تعرب في الآية من جهة الصناعة النحوية: نصباً على المصدر، أو نصباً بفعل مضمر تقديره: اتبع والزم فطرة الله.
والمعنى في جميع الأحوال: أقم وجهك للدين الحنيف -أو الذي هو الحنيفية- والذي هو كذلك أو في الوقت نفسه فطرة الله. وقد أكدت الآية هذا المعنى بقوله تعالى: ﴿الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا﴾ أي أن الناس أو البشر مخلوقون على هذا النحو الإيماني، مطبوعون عليه، لأن هذا يمثل نزعة أصيلة ثابتة في نفوسهم. وإن كانت تعرضهم أو تعرض لهم العوارض، والتي ذكر النبي ﷺ الأبوين مثالاً لها، أو تنبيهاً على أوّلها وربما أخطرها كذلك، وهكذا تأتي كلمات: «الدين» و «الفطرة» و «الخلق» في الاستعمال القرآني في هذا السياق مترادفات أو كالمترادف! قال ابن عطية في تفسير الفطرة: والذي يعتمد عليه في تفسير هذه اللفظة أنها الخلقة والهيئة التي في نفس الطفل التي هي معدودة مهيأة لأن يميز بها مصنوعات الله تعالى، ويستدل بها على ربه جل وعلا، ويعرف شرائعه، ويؤمن به، فكأنه تعالى قال: {أقم وجهك للدين} الذي هو الحنيف، وهو فطرة الله الذي على الإعداد له فطر البشر، لكن تعرضهم العوارض.
- وأمر واضحٌ رابع تدل عليه الآية الكريمة، يتمثل في الإجابة عن سؤال أو اعتراض فحواه: ألا تتحول هذه الفطرة وتتبدل، أو «تتطور» -كما يقال- في قادمات الأيام، وبعد دهور وعصور، بحيث تستغني عن الدين والإيمان؟ أو بعبارة أخرى أو سؤال آخر: ألا تستغني هذه الفطرة عن الدين حين يرتقي ويتقدم (علم) الإنسان، فيرتقي به إلى الفضاء، أو يحمله إلى الجوزاء؟ أو يصل به إلى اللجج وأعماق البحار؟ أو حين يقفه على طائفة كبيرة من قوانين الطبيعة، وسنن الإنسان؟ الجواب: كلا، والله تعالى يقول: {لا تبديل لخلق الله} أي لا تبديل لفطرة الله التي خلق عليها إنها لا تتبدل من تلقاء نفسها بفعل التطور أو زيادة الإنسان بالمعلومات والمعارف، ولا تبديل لها من جهة الخالق، كما أعلمنا سبحانه وتعالى في هذه الآية.
- وأخيراً : تأتي كلمة «الدين» في الآية الكريمة حالةً محل الفطرة، وفي معنى المبدلة منها أو المعطوفة عليها: {ذلك الدين القيم} فعادت للحديث عن الدين الذي صدّرت به الآية، وذلك للتأكيد القاطع على أن دين التوحيد الذي جاء به محمد ﷺ يكافئ الفطرة الإنسانية ويساويها، ويلبي جميع أشواقها وتطلعاتها، وأنه لا بد منه للحياة الإنسانية السوية.
مختار من كتاب: «الوجودية وجذور الفكر القومي والعلماني» للدكتور عدنان زرزور. اختاره وهذبه: د. إبراهيم إسماعيل.