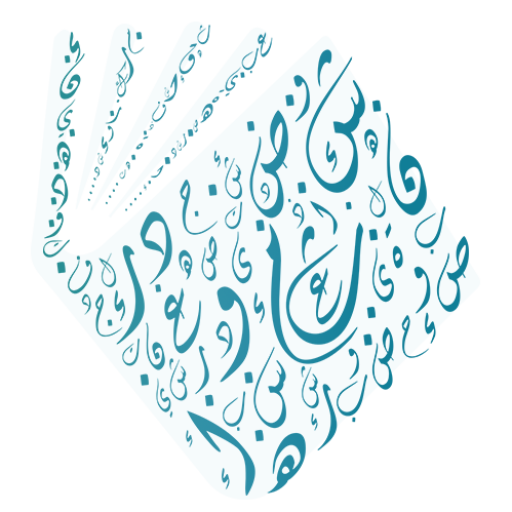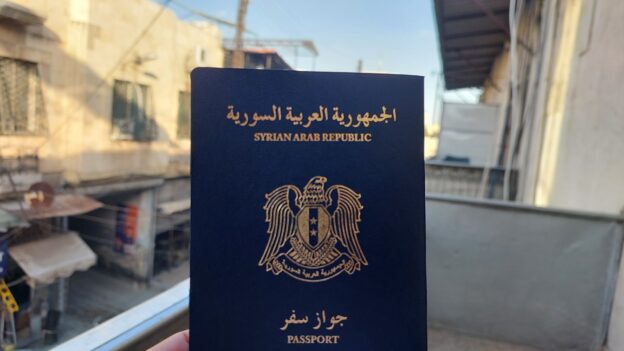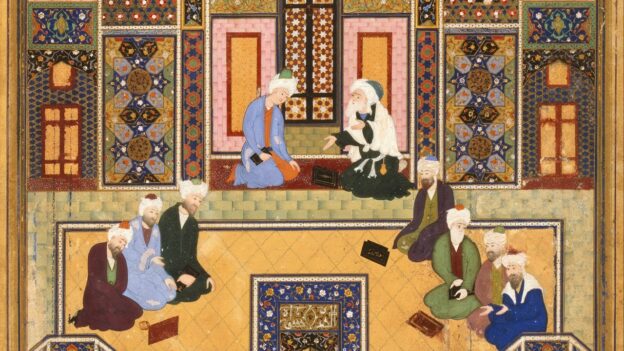[ المقالة ]
بِخيطٍ من حِبر: قراءةٌ مُطوّلة

أمّا قبل:
قبل أشهر..[1] أرسلَ إليَّ د. خالد بريه، كتاباً ما ولد بعد.. طال عنه الحديث، تأشبت أفكاره، وتفرعت أغصانه، وظهر موسوماً بخط لطيف “ميلاد النص”
قال اِقرأه وأشر عليَّ، هل يكون الكتاب القادم؟
قمتُ من عنده، ارتسمت في مخيلتي خطوط عريضة ها هنا وهناك “هذا لو كان كذا لكان أصلح، لو أضفتَ كذا وحذفت كذا، لو فعلت وفعلت…! ” أتيحت لي فرصة للنقد، ولتقييم هذا النقد، وربما لتخليده في هذا القادم الجديد!
في طريق العودة قلّبت صفحاته..
بدءًا بـ “اعتراف” وانتهاءً بـ “بين الرواية والدراما”، لم أنهه في الجلسة الأولى، لكنه احتلني فيها.. كتبت أسطراً مقرِّضاً الكِتاب، أرشحه للخلود.. أريده يحتلُّ مقام “جواهر الأدب” الذي سبق بأكثر من خمسين سنة، قلتُ انتهى عصره، وأتى ميلاد النص.
باعتباري كاتبا، وقع الكتابُ على أمور كثيرة في نفسي؛ ما استطعت التعبير عنها، واجترَّ صفحات من أصل مادة الكتابة، فوضعها جليةً للقارئ، وأحسب لو أنَّ رجلاً لا يمت للكتابة بصلة قرأه؛ لاشتهى أن يكون كاتباً ليتحقق بتلك النعوتِ السامية…!
وانطلقَ قلم الكاتب يتحدث عن الأدب، والأدباء، وتجاربهم، وحربهم السرمدية للكتابة حتى انصاع لهم القلم.. كان في الصفحات كأنه يوجّه بوصلة الكاتب بسلاسة تنقاد لها القلوب.. بأسلوبٍ غاية في النبل، غاية في الإقناع، يخطُّ للكاتب جادّة ممهدة لقلمه، يوقظ في جنباتها مواطن إبداعه، وظلَّ يخطُ ويخطُ إلى أن كان لنا الكتاب “بخيطٍ من حبر؛ دفقة من الضوء، والغواية والأدب“
وقد أحسنَ في كِلا العنوانين، على أن العنوان الثاني كان له حظٌ أوفر من الإبداع، إذ جعل مجرد تسريح الخيال في دقائق هذا العنوان اللطيف؛ حقلاً خصباً للمتأمل!
عَلِّي باطلاعي على المسودة الأولى له حظيتُ بكامل النصوص، فالكتاب: كلما تقادم الزمن عليه؛ شاخ فتناقصت حروفه طمعاً في الكمال.. عدا أنَّ الكتاب الذي بدأ ميلاداً للنص، وتمَّ كدفقةٍ من الضوءِ والغواية والأدب، زاد وزاد حتى كمُل، ونقصُ الأخيرِ نصوصاً من الأول؛ ضربٌ من الكمال المنشود.
استلمتُ نسخة من الطبعة الأولى للكتاب قبل أيام، تغيّر كأني سافرت عنه دهراً، فلما رجعتُ، إذ به قد استوى، وتم شبابه، فهو على أكمل ما يكون.. مُذ قال الكاتب : “تقول الحكاية” إلى أن قال: “على سبيل الختام”، يخوض بك في شتى بحار الأدب، مجلّياً لك صنوفه وفنونه، ناثراً لك قصائد الأدبِ شطراً شطرا..
النص وعملية الخلق، تطوافٌ من شرفة شادٍ.. أدب الرسائل، المجلات الثقافية…
يعزفُ في كلِّ مقالةٍ على وتر من أوتار الأدب، فإلى تمام الكِتاب؛ يخلع العربي العباءة، ويطوّح الإنجليزي بالقبعة، وينحني لهذا الأدب أهل الشرق…! فقد استوفى الكاتب من آدابهم جميعاً!
***
بين دفتي الكِتاب:
يقول بريه في ختام مقاله “تطواف: من شرفة شادٍ للأدب” : “لقد تركتُ العنان للقلمِ أن يثرثر كثيرًا، حسبي أن تستلطف هذا التَّطواف من الأدباء، وشيءٌ مما يتعلق بهم.
والحقيقة أني أحصيتُ كم من الأدباء طوَّف بنا، فإذا هم أكثر من عشرين! لا يهذّهم هذّاً، إنما يسمعك صدى أقلامهم كالتراتيل، فأنت على أعتاب المقال تتلفت، وإذ بعشرين أديبا مِن الكِبار -كما يحب بريه وصفهم- يلوحون لك، يقولون: عُد للتطوّاف، كأنك زرتنا! وأذكر أني قرأت المقال في نسخة الكتاب الأولى، وفي النسخة الجديدة كذلك، حرفاً حرفاً.. بل مرتين، لأنه مقال واحد، كأنه مقالات!
بين الصفحات، تذكرت عبارة د. أحمد البحر في تقديمه للكتاب: “هذا الكتاب الماتع… يصلح ببراعةٍ عجيبة لزماننا المستعجل. فأنت تستطيعُ أن تُنزل العبارة على أيِّ صفحة من هذا الكتاب، فتراه تكلّم عن الأدباء، وتكلّم عن فنونهم، وعن الأدب، ونقل واختار بعناية فائقة أصلح ما يكون في كلِّ مقام، وكلّ اقتباساته تصلحُ لأن تحيا في الزمان، فقد استقامت له القريحة في اختياره، وانظر مقاله “أدب الرسائل”، فالمقالُ تقوم فكرته وتتكامل في العنوان “أدب الرسائل: فنٌّ على حافة الاندثار” فكأنه يوجّه دفّة الكاتب.. -الكاتب الذي أصبح توّاقاً ليتميّز صيده في الكتابة التي ابتذلت وذلّت لكثرة الوالغين فيها- للرسائل، يقول هاك فنٌ ما عاد يُطرَق، فاشحذ إليه ذهنك. وكعادته، مختصراً لك الطريق، ممهداً لك السبل، يقول: “جاء في كتاب فلان لفلان، وقال فلان الكاتب لفلان الأديب، وحفظ التاريخ كلمة فلان…” إلى آخر ذلك؛ يجتاحك الشوق لتكتب.
***
أجد المقام ينأى عن أن يكون مقام مطارحة أشواق الكتابة والأدب، لكنه بحال من الأحوال مرتبطٌ بالكتاب رابطة كرابطة الدم، والأدب والأدباء بعضهم من بعض، فأنا أجد في نفسي دافعاً قديماً للكتابةِ عن مجلة الرسالة، بيني وبينها غرامٌ غريب، ما التقيتها، ولا كُتّابها، ولا وقع بيدي عددٌ من أعدادها، بل إلى اليوم ما قرأتُ للزيّات حتى…! لكنّي أحبه، وأحبُّ تلك المجلة التي يفتنني اسمها، وأراني مديناً لها بالكثير.. أَهيمن عليَّ صيتها وسطوتها التي تركتها في أبناء الكِتاب؟ أأحبّها لآثار كِبار الأدباء الذين أحبهم؟ “لِخَولَةَ أَطلالٌ بِبرقَة ثَهمَدِ”.. وقد ذكَرني “بريه” في الفصل الثالث من حكاياه عن المجلات الثقافية هذا الود القديم بيني وبين الرسالة؛ والمرء مع مَن أحبَّ، فهل أنال منال القوم لحبهم؟ ولعمومِ الكُتابِ عندي مقام رفيع، وجُلُّ أهل الأدب عندي من العلماء، بحارٌ وأخطاؤهم أقذار، والماء إذا جاوز قلتين؛ لم يحمل الخبث، ها هم أولاء تربّعوا عرشَ الأدب العربي واعتلوا ناصيته، يغتفر لهم ما تقتلعُ به رؤوس غيرهم، وأزعم -ولا أظنني أبعد عن الصواب- أن الأديب إنسانٌ حلّاه الله بمنحٍ لن تكون لغيره، نبيٌ بغير وحي، رجلٌ بقلبين، يعيش حيوات كثيرة، تنتهي لقلبه صيرورة الفكر الإنساني، تصبُّ المشاعر بـقلبه فترتفع به إلى سماء الله، فيهبطُ منها إلى أرضه وقد نال مِداداً من بحر الله… ليس على الأديب حكم بالفناء إذا انتهى عمره، وعمر الأديب لحظة في حياته، وأنتَ في غنى عن التدليل لذلك، فالمكتبات تزخر بحيوات أُناسٍ قبضهم الله إليه، يسمرون معنا في الليل، يشيرون علينا في الحوادث بعدهم، نضيف حياتهم إلى حياتنا فنكبُر.. فالأدبُ وقار بغير شيب، والأدب طول عهد الشباب، ودوام حياة القلب، وعمق البراءة، وبعثُ الطفولة في الروح مرات ومرات. قلتُ سلفـاً: الأدب صنعة النفس، والنفس معتلجٌ خُلِقَ الإنسان لتقويمه، ولا يُقوِّم الإنسان أمراً لا يفهمه… فمن للنفس وأغوارها إن استلب الله أدباءهم واجتباهم إليه…؟ فتعلّقوا بأسمالهم، يرفعكم الله.
ونرجعُ للكتاب الذي أودع فيه صاحبه آداباً عزيزة في فضاء الأدب… والمسألةُ التي فطن إليها الكاتب في مقاله “اِرتِحالات اليراع: من النَّصِ إلى غوايةِ الاجتزاء” مما لا يسلم منه مبتدئو الكتابة، ومن نجا من تلك الهاوية فإنما بفضلِ من الله وسابق عناية، وخاصّةً في زمان كـزماننا.. الزمن الذي اجترأ فيه الوضيع على مقام الأشراف:
“زمنٌ كأُمِ الكَلبِ ترأمُ جروهــا وتصدُّ عن ولد الهِزبرِ الضاري”
وعلى قِصر باعي في ساحات الثقافة، رأيتُ من لا أُسميهم، ومن لا أحصيهم، ممن يعدون عَدو الضباع على فرائس غيرهم.. حتى لترى آسادَ الأدب كدّوا سنواتٍ في سبيل من السبل، وبعدُ يعدو على مجهودهم ضبع ممن ما بلغ أشدّاً ولا استوى، إن كان عدوَ سرقةٍ واجتزاء أو احتقار وتشويه، وقد فصَّل بريه في ذلك تفصيلاً شافياً، حريٌ بكلِّ مَن أراد الخوض في بحر الكتابة أن يستقي منه.
وخذ من ذلك قوله في الختام “أن تكون مطبوعاً على الفهم؛ والحذق، أو لديك “طبعٌ قابل”، كما قال ابن الأثير، ليس بكافٍ أيضاً، بل يحتاجُ منك إلى اشتغالٍ مُضاعف، وتطوير الأدوات المساندة، ومجاهدة نفسك على التَّواضع؛ لأنك تمضي على عماك في الوقت الذي تشعرُ فيه أنك المبصر الوحيد!”
***
ثُم تكلَّمَ بُريه عن سرِّ الأبجدية في إنتاج نسقٍ إبداعي، بدأ المقال بتساؤلٍ ظريف: “هل يكمن الإبداع أساساً في تلك الحروف التي تبوحُ لكلِّ مبدع ببعض الأسرار؟! أم أن سر الإبداع يكمنُ في المبدع ذاته”؛ وقد ذكرني هذا التساؤل بمَن يريد تحكيم كتاب الله بغير رجال، فنجعلُ الكِتابَ في منبرٍ عالٍ، وننظرُ إليه من أسفل، ننتظرهُ أن ينطق؛ في السطر التالي لِـما اقتبسته، انتقل بنا بُريه بعيداً -كما يظهر لأول وهلة- فراح مُعدِداً فضائل النسيان بأحداثٍ متباعدة، ولمّا ألقى القارئ عصاه في المنزِع الجديد، عاد به بُريه مشيراً لخيط غايةً في الرهافة واللطف، واصِلاً به إنتاج النسق الإبداعي بعامل النسيان والدهش، ثُم استمر على عادته واصِلاً الخيوط، فما انتهى لآخر المقال إلا وقد تكامل النسجُ بين يدي القارئ بقوله: “والإنسان يعيشُ ليروي، كما يقول غابرييل غارسيا ماركيز، ولكنه، كذلك، يعيشُ لينسى، وإن لم ينسَ فعليه أن ينسى، ومن الذَّاكرة والنسيان يُولد الأدبُ ومختلف أشكال الكِتابة”
وبعدُ في المقالين قبل الأخير في الفصل الأول، يلمَحُ القارئ أن بريه نهج بنا نحو درب جديد، يُبدعُ فيه ناسجاً خيوط النصّ والصورة، مبيّناً وحدة النتيجة، في التلقي بين صورة النص ونص الصورة. وكأنّه قد جعلهما شيئاً من تقديم للإطار النظري الذي يريد أن يلجَ إليه بأقدام الحقيقة العملية، فأنزلَ لنا شيئاً من نظرية التلقي مبسطاً إياها في هذين المقالين، ليستمر عليها في عدة مقالات بعدُ في الكِتاب.
في آخر مقالات الفصلِ الأول ملمحٌ لطيف.. “الطريق إلى الثراء: نصٌ وخيالٌ وعطرٌ رديء” يضحكُ ملء فيه يقولُ لك: إن كنت تكتب للثراء، فارمِ القلم!
***
الفصل الثاني: الحبرُ الشاحب: أفضل من أقوى ذاكرة.
“الرواية وسردية التاريخ” علاجٌ ناجع، ذاك الذي أعدّه بريه لمُستقلي الروايات، المتكبرين عنها.. وقد وصف انطواءات الرواية الخالدة وصفاً مُطوّلاً أبانَ فيه عن أصلِ جوهرها الذي يزداد ألقاً بمضي الزمن، وخذ من ذلك قوله: “ناهيكَ عن التصوِّر المدهشِ لحياةِ الإنسان، وتقلباتِه، وخيباته، وأسرار النَّفس، ومتاهات الروح، وصِراعِ الذكرى والنسيان في أعماقه، وفضاءات الدَّهشة في قراءة حياة المجتمعات، وقراءة للمكان، وتصوُّر لهيبة العمران…” وقد وُفِّقَ في إنهاء الفقرة بقوله: “كل هذا وأكثر؛ يأتي في بطن رواية، تظنُّ في ظاهرها قصة حبٍّ بين شابٍ وفتاة، وهي في حقيقتها أعمقُ مما نتخيل، وأكبر مما نظن. “
ثُم استلَّ القارئ من امتداد الروايات وتشعباتها ليضعه مع العنوان، على صراطِ الرواية التاريخية، معلّلاً ذلك مرتين، “الرواية هي النَّوع الأدبي الأكثر اشتباكاً بالواقع التاريخي”، وأُخرى “من الحقول الروائية التي تثير انتباهي كثيراً”، وأسهبَ في ذكر عدّة روايات تاريخية أراد نفخ الروح فيها أمام القارئ العربي، وقد استرعى انتباهي كلامه عن فريدة وليد سيف “صقر قريش”، وقد أفاض في تحليل البُعد الوجودي الذي أضفاه وليد سيف في كلامه عن الخادم بدر الذي أهمله التاريخ.
وفي بديعته “الزير سالم: ميلاد الذات في رحم الموت والفناء” دراسة نفسية أدبية فاخرة لبطل تلك الحقبة الغابرة، وقد فكَّ عُقد المعارك تلك بتجلية انسجامها مع الإنسان في معارِك نفسِه الخفية، سالًّا أسطورة الزير من أثوابها، مطّرِحاً تلك الحمولات الثقيلة التي شكّلها التاريخ على ظهر الحقيقة؛ “لتطوى صفحة نموذج إنسانيِّ يقضي حياته في محاولة الظهور وسط جو خانقٍ من النكران”
وبعيداً عن الكِتابة.. لكن كالقريب، منبثقاً مِن وحي الأدب، بأنفاس الأديب، أخرج إلى النور بريه “تباريح الوجع على أعتاب قرطبة”؛ ويصلحُ لِمن أحبَّ التصنيف أن ينظمها في سلسلة النصِّ القصصي المترع بالأدب، والنور، والألم. وليس عنها ببعيد ما خطَّه في مقاله “سلّامة القس: ولحنها المخضَّب بالأدب” على أنه نحا ثّمَّ إلى المقارنة بين سلّامة والرافعي في “سمو الحب”، وسلّامة القس عند باكثير، ليجعل في ذلك محاولة مترفــة لبعثِ خيال أديبٍ يماني -مرةً أُخرى- من شرنقة اليمن العتيق، إلى شسع عالمٍ لطالما غضَّ عن آداب اليمني المعاصر تحت وطأة التهميش. وعلى هامش الحديث، أقول: قد روِيت سلّامةُ مِن بحر الخُلود مرةً عند الأصفهاني أبي الفرج، وأُخرى بتراتيل حجّة البيان الرافعي، وبعدُ بِرَويِّ الخالدِ باكثير، وكما بُعثت من قبل، بعثها بريه بلحنها المخضَّب بالأَبد.
***
“الرافعي في وجدان المقالِح: مرافعة تاريخية” وهو آيةٌ مِن آياتِ الوفاء التي ما زال وحي الرافعي، وأدبه، وضريحه استحقاقاً يستمطرها عاماً بعد عام؛ بعد أن استهلَّ بغراميات في آدابِ حجة البيان، جلّى بُريه في مقاله المقالح محتفياً بالرافعي، باكياً على غدراتِ الزمن التي احتضنت تراثه آنذاك، “الرافعيُّ أحد الأعلام الكِبار في الفِكر والأدب، وأحدُ الذين حرثوا تربة العصرِ البِكر” الجاعلِ لنا “شكسبير كما للإنجليز شكسبير، وهيجو كما للفرنسيين هيجو، وجوته كما للألمان جوته” والرافعي، مُستمِداً مِن شواهقِ العربية العصماء، علاهُم، فما يقاسُ بهم إلا لِتُعلَم غلبته عليهم. وإذ حلّى بريه مقاله بالرافعي حنيناً واعترافاً، فاض الجمالُ على السطور حتى جعل مِن مرافعته قصيدةً مِن قصائد الزمن.
“مسارات النظر في معاني الاستمداد: من الشيخِ إلى المريد” وهو مقالٌ متخمٌ بديع وقعَ على جرح عميق، وثَلم في جسد الأمة الإسلامية اليوم، وقد استهل بريه المقال بموقفٍ عابر، رامياً عن طريقه حبلاً في مسارات الاستمداد، وأتبع الموقفَ مواقف نقلت القارئ إلى عمق الصورة، عبرها انتقل بريه للحديث عن الشخصيات الفاعلة التي كان لها كبير الأثر في زمانها، فالزمن الذي يليها، قال: “يتضِّحُ أن بعض الشخصيات العلمية والفكرية والقيادية هي أشبه بصيحةٍ مدويةٍ أوقدت أسراب الغافلين قديماً وحديثاً. يظهرون في لحظة فارقةٍ يكون الزمن بحاجةٍ إليهم فيها” على أنه اقتصر في ذكر هؤلاء الصيحات في الجانب الإسلامي فحسب، وأرى لو أنّه تكلّم عن كِبار مفكري الغرب الذين ترجعُ إليهم يد الفضل في نقل العالم الأوروبي من قرونه السوداء إلى عصور التنوير -على ظلامياتها- لكان المقال بذكر ذلك أتم في معناه وأشمل في موضوعه. وقد أحسن في تشخيص سبب الأثر الذي يتركه هؤلاء القوم فيمن بعدهم، قال -مستعيناً بالإمام الأفغاني أُنموذجاً: “ولعلَّ من أتوا بعد الأفغاني كانوا أعلم منه، وأغزر إنتاجاً، لكنَّ التهيئة الإلهية للقيادة لم تكن من نصيبهم، أو لم تَرقَ هِممهم إلى الهمِّ الذي سكن وجدان الأفغاني، أو أن الزمن لم يكن بحاجة إليهم بعد أن كثر دعاة الإصلاح، وذاع فكر النهضة” وأفاض: “وهذا الأمر ينطبق على شخصية محمَّد بن عبدالوهاب النَّجدي، وحسن البنا، فلو أعملنا قاعدة الميزان العلمي في التأثير، والإرث التأليفي؛ لاتضح لنا أنَّ كل ما تركاه بضع رسائل هي إلى الوعظ والإرشاد وبدايات العلم أقرب منها إلى التحرير والتأصيل.
ولو وُزِنا بميزان العلم والتأصيل والتحرير؛ لتبين أنَّ هناك من تلامذتهما من يفوقهما علماً وتبحراً في كل الفنون، بل، ومن أقرانهما المعاصرين لهما، ومختصر ذلك كان في قوله: “الأثر العظيم في تغيير مجرى التاريخ المعاصر… ناشئ من طبيعة الشَّخصية، والقدرة القيادية، والبيئة التي دفعتهم، ليكونوا أصحاب مدارس، امتدَّ أثرها إلى لحظتنا هذه. ومن هذا المنطلق ينبغي أن يُنظر إلى الشخصيات التأسيسية -إن صحّ التعبير”. وأختمُ قراءتي في المقال بقوله في وصف الشخصية المؤثرة التي يحتاجها زماننا الراكد ليتحرك: “رجل فِكر، هضم الموروث الإسلامي والفكر الغربي، يتقن لغاتٍ متعددة، حادِّ النظر، بعيد الغور، واسع الاطلاع، يتحدّثُ عن قضايا الإنسان، والإلحاد، والفكر والدين، والأدب والفن، والنهضة ومشكلات الحضارة، بطرحٍ مُغايرٍ للأسلوب الوعظيِّ المعتاد”.
وفي امتداد لِـما بدأ بُريه في تقعيده من آداب للكتابة، استهلَّ مقاله “الوهم المعرفي: ارتفاعٌ للسقوط” -على غير عادته- بقول مباشر: “أكثر ما ينبغي تهذيبه وضبطه، ردود الأفعال تجاه ما يكسِر أفق توقعاتك، لاسيما في عالم الثقافة والمعرفة”، وألمح في طيات مقاله هذا إشارة لأصلٍ من أصول العلم في الموروث الشرعي، وهو قولهم: مَن قال لا أدري فقد أفتى. ترى ذلك في قوله “أن تقول: لا أعلم؛ لم أقرأ؛ لم أقف عليه؛ هذه جُملٌ تدخلُ في رصيدك المعرفي والخُلُقي، ولا تنقصُ مِن قدرك؛ لأن النقصان الحقيقي أن تدّعي شيئاً لا تملكه”.
***
الفصل الثالث: تعليقٌ عابرٌ في جداريات النص.
“فائض المعنى: مِن البعثة إلى انهيار بُرجي التِّجارة العالميين” قراءةٌ في كِتاب “موجز تاريخ الإسلام” لـكارين آرمسترونج.
لا أحبُّ أن أسعى لجعلِ قراءتي هذه قراءة في قراءة، لكن حسبي ها هنا تعليقات عابرة فيما يخصُ هذه القراءة الحاذقة للكِتاب، إذ قد أشاد بريه بإنصافِ الكاتبة في أكثر من موضع، تفوحُ من إشادته تلك فرحة الوصول بعد العناء، مِن قارئ كثيراً ما التقى بصفحات عنيفة الكذب، كثيرة التزوير والحطِّ من شأن الأمة التي نما الكاتب فيها، وأودعَ أرضها جذوره، فكانت آرمسترونج بكتابها كالماءِ البارد على الظمأ، وقد تكلّم بريه عن مراحل/فصول الكِتاب الخمسة، مفيضاً في الفصل الخامس لارتباطه بالمرحلة التي تعيشها الأُمة اليوم، والحقيقة أني كُنت أنتظرُ استدراكاً من بريه على الكتاب تلبيةً لمجهول ما في نفسي، وقد فعل.. قال: “ولا يعني هذا أن نسلِّم للكاتبةِ في كل ما ذهبت إليه، إذ بدا لي…” وقد راقني استدراكه، كما راقني تقريظه إنصافها في سطور التاريخ المتشحة بالضباب. ختم بريه المقال مشيداً بترجمة الراحل د. أسامة شفيع السيد -رحمه الله- حاثّاً مترجمي الأمة لاحتقاب “المادة اللغوية الرفيعة، وفخامة اللفظ، والعلوِّ في اللغة، والسلاسة في السرد..”
ولو سِرنا على أساس اتساق نظمِ خيط الحبر، نرى أن بريه لا يزال مستمراً متشبثاً بنظمِ ما يعني الكاتب في خيط الكِتاب، ففي مقاله “سيلُ الذكرى في بِساط الثمانين” يقدّم ما يقرُب من أن يكون دراسة زاخرة لذكريات د. حسين حنفي؛ أحد أهم رموز اليسار الإسلامي، وقد تناول بريه بدايةً كتب السير الذاتية والذكريات في حديث مطوّلٍ، ثُم عاد للحديث عن ذكريات حنفي، وبعد كلام طويل وتفصيلٍ في المشروع الفكري للدكتور حسين، وبعد كلامه عن ذكرياته وعن “تحطيم قيود الحياء البشري”، وبعد الإشادة به في مواضع وإنصافه في أُخَر، إلى قوله “هذا النص يختزل بكثافة معالم فكر الأستاذ حسين حنفي، ورؤيته للحياة، والدين، ونظرته إلى المرأة، والفن، وهي عمود أفكاره ومشروعه الذي نثره في جميع كتبه التي بلغت قرابة خمسٍ وثلاثين ألف صفحة، ومن هنا تأخذ ذكريات حنفي أهميتها، وقيمتها المعرفية؛ لأنها تتضمن “خلاصة الخلاصة” في فكر الرجل، وطريقة تفكيره، والفكرة التي ينطلقُ منها، والرؤية التي يؤمن بها، بوضوحٍ غالباً تستدعيه كتابة الذكريات”؛ والرجلُ بحكم كونه أحد أهم رموز اليسار، ترى أن الإشادة به وبأدبه وفكره ومشروعه تهمة بشكل أو بآخر لِمن لا ينتمي له، لِذا؛ يستدركُ بريه : “لا يعني هذا أنني أتفق أو أقفُ مع فكره، لا لا، بل بيننا جُدُرٌ تحولُ بين اللقاء والوفاق، لا سيما في مفاهيم الدين وأصوله الكبرى، وإنما أجدني مندهشاً من قدرته على التحمل، وأمنياته الكبيرة في آخر خريف العمر أن يتمَّ بقية كتبه ومشاريعه، وألا يقبضه الموت إلا وقد أتمها”، ويعنيني من ذلك الخيط اللطيف الذي تراه ممتداً بين مقال بريه “الوهم المعرفي: ارتفاعٌ للسقوط” وبين هذا المقال، وهذه القراءة للذكريات. لترى الكاتب بعد أن استهل ذاك بقوله: “أكثر ما ينبغي تهذيبه وضبط؛ ردود الأفعال…” يُري القارئ نموذجاً عملياً للتعامل مع القامات الكِبار، وإن تجذّروا خلفَ جُدُرٌ مِن الخِلاف..
***
راقني التحليل النفسي لشخصية بابلو اسكوبار في مقاله ” الاختيار الموهوم وفلسفة التأله”، ووددتُ لو أطال فيها، فالإسقاطات التي يخرج بها الكاتب كثيرة، وحديثه حول النفس وتفصيله في شأنها وتحليل ارتباطاتها مع الواقع دقيق، كما ظهرَ ذلك قبلُ في مقاله عن الزير سالم، أو في الآخر ” وهم التقديس في حجر الضوء الأزرق “؛ وبالرجوع إلى الحديث عن “الاختيار الموهوم”؛ أقتبس من قوله ما يصلح لأن يُسقَط على جماعة من طلبة العلم، أو الكُّتاب، أو من هم على تماسٍ مع الثقافة ممن ما تأدبت نفوسهم عن دورانها حول ذاتها: “فكرة الاختيار التي يتلبَّس بها بعض المهووسين، تأتي مقرونة بالتيه، تتسقُ مع الأفراد والجماعات، والمجتمعات على حدٍ سواء، ثمة أفراد يرون أنفسهم من المختارين، وثمة جماعات كانت تظن أن الله اختارها لتكون في هذه الأرض حارسةً للكون! وثمة مجتمعات من فرط النعمة التي تحيطُ بهم، يظنون أنهم قد اختيروا منذُ الأزل؛ لأنهم أهلٌ للمكرُمات! وجميع هؤلاء، أفراداً وجماعات، ومجتمعات، وأُسر، ونُخَب، سيصابون حتماً بالتيه، التيه المزلزل لفكرة الاختيار؛ لأنهم وقعوا فريسةً لأفهامهم وأهوائهم”، وقصدت مَن ذكرتُ لفشوِّ ذلك فيهم، وإلا فالأمر بالعموم الذي ذكره بريه.
ويستمر بريه في التحليل في مقاله “قن الديوك: لماذا يقبل البعض أن يكون مستعبداً؟” ليقول فيما ورائيات رواية “النمر الأبيض”، طارِقاً حالة الاستعباد المرَضِية المستحكمة لدى بعض البشر، المسكونين بالعبودية، لينتقل من “النمر الأبيض” لكتاب دي إيتيان “مقالة في العبودية المختارة” منه إلى “يوتوبيا” بديعة أحمد توفيق، فترى المقال مقالاً متداخل الفقرات، موحّد الفكرة، يخرج الكاتب فيه من كتابٍ لآخر في جولة حول موضوعه الرئيس.
وفي آخر مقالين، على دكة الخِتام، أخذ بُريه بالحديث عن “استنطاق الحيوان: من ابن المقفع إلى مزرعة أورويل” واستفتح فكرة المقال بالحديث عن أفكار الكُتاب وخيالاتهم التي لا تتاح لهم الفرصة ليعبروا عنها بالكتابة المباشرة، لتنشأ عن ذلك فكرة استنطاق الآخر.. ومن ثم شرع في الكلام عن الكُتب التي وُضعت على ألسنة الحيوانات، واضِعاً بين يدي القارئ عدة مؤلفات وأسماء تنقله للعمق التطبيقي للفكرة، عدا أني ما قرأت العنوان إلا وقلت: “يذكُر بريه الرافعي وصفحاته الخاصة من كليلة ودمنة، وكدت أنتظر ذلك لآخر سطر لولا أنه انتقل للحديث عن فلسفة الطغيان المصوّرة في مزرعة أورويل. “
***
خِتاماً، في التفات سريع للكِتاب الذي عَمدَ فيه بريه إلى بناء الأركان المؤسسة للكتابة في هذا العصر، تراه كأنما هو مكتبة حيّة، أو معرض بديعٌ مُلهِم للفكرِ والآداب، خاض بريه فيه بحر الكتابة، ورصَّ بدائع الحِكمة الصانعة للكاتب التائه في خضم مخرجات المطابع العشوائية اللانهائية، فأنتَ معه لا تنتهي من أدبٍ للكتابةِ، وسببٍ في مقالٍ؛ إلا وتراه يدفعك لآخر، حتى إذا وقفت على دكة الختام؛ رأيته يقول لك: ” الإنجاز الحقيقي؛ ما يعنيكَ أنتَ دونَ سواك ” “وتذكروا: مَن سار على الدرب وصل، والدروب متعددة بتعدد الخلائق، فما كان درباً لغيرك، ليس بالضرورة أن يكون درباً لك! فأحسنوا المسير.”
[1] قبل عامٍ من تاريخ نشر هذا المقال.