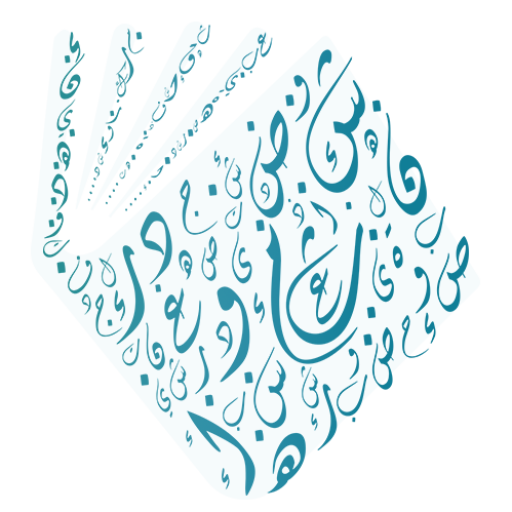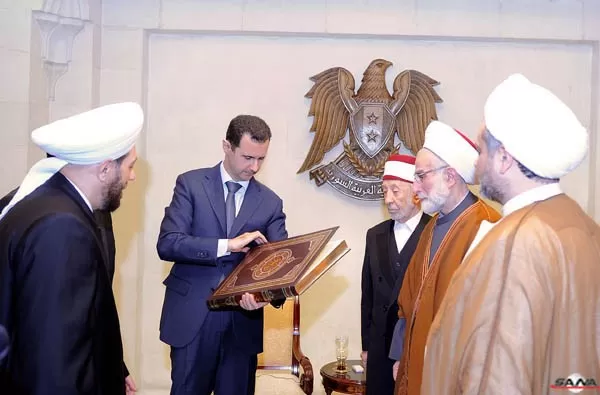[ المقالة ]
الجماعات الإسلامية العربية بين الولاء للأمة والولاء للوطن

بنظرة فاحصة على خريطة الحركات السياسية في العالم العربي نجدها لا تخرج عن ثلاثة أصناف عمومًا، حركات سياسية تحمل إيديولوجيا إسلامية، تقابلها حركات سياسية بأيديولوجيا علمانية، والنوع الثالث حركات وطنية داخلية لا تجد في أولوياتها أيًا من البعدين الإيديولوجي الديني أو العلماني، وتجد فيما بينها العديد من الحركات التي تتظاهر بالبعد الوطني أو القومي، وهي في حقيقتها تستبطن إيديولوجيا علمانية أو إسلامية.
تمتاز كل من الحركات الإسلامية والعلمانية بحمل أهداف أكبر من القطر التي تعيش فيه، وليس في هذا محظور من الزاوية الثقافية أو المنهجية، فلكل من يملك الاختيار أن يختار، ولكل من يشاء؛ أن يشاء ما اعتقد أو شاء، طالما أنه لا يعتدي على حقوق الآخرين. ولكن إيغال بعض هذه الحركات بالبعد العالمي أو القومي الواسع والانشغال به؛ أفقدها القدرة على الأداء السياسي الفعال في الواقع القريب الذي يحيط بها. والحديث هنا عن الحركات الإسلامية السياسية وحتى المدارس الدينية غير السياسية، وإن كان كل ما يجري عليها يجري على الطرف العلماني المقابل، لكن هذه ببعد حداثي مادي، وتلك ببعد ديني.
فوارق بين الحركات الإسلامية العربية وغير العربية:
إن أحد أكبر الفوارق بين الحركات الإسلامية السياسية العربية وغير العربية، عدم قدرة الحركات العربية على الثبات في الوطن في ظل المحن، واعتيادها الهجرة وقت الضيق.
فمعظم الحركات الإسلامية في الهند، وباكستان، وبلاد التركستان، وتركيا، وماليزيا، والفلبين، والبوسنة تعرضت للمحن التي تعرضت لها الحركات الإسلامية العربية، ولكنها لم تفقد الثبات كما فقده العرب، خاصة في بلاد المشرق العربي بخلاف الواقع في مغربه.
إن هذا الفرق واضح أتم الوضوح عندما يحاول الإنسان أن يقارن بين النموذج التركي والنموذجين المصري والسوري مثلًا، لماذا ثبت الأتراك، ونجحوا إلى حد ما؛ في حين لم تثبت هذه الحركات في بلدانها العربية، وبالتالي لم تنجح بشيء كبير.
من داخَل الحركات الإسلامية والمدارس الدينية في مصر، وسوريا، وتركيا يجد أن الفرق الجوهري بينها هو الانتماء، أبناء الحركات الإسلامية العربية انتماؤهم الفكري للإسلام فقط، ولا تجد لهم انتماءً فكريًّا – وبالتالي وجدانيًّا – للوطن الذي يعيشونه، ولا للعروبة التي نشؤوا في كنفها، تجد ذلك في كل من المدارس العلمية والصوفية كما تجده في الحركات السياسية، فتكاد لا تجد مؤسسة دينية في الوطن العربي تجمع بحقٍّ بين الانتماء للإسلام والانتماء للوطن، أو القوم الذين ينشؤون بينهم، بل يرى كثير منهم ذلك نوعًا من الكبائر التي لا يقبل بها الإسلام. بخلاف الإسلاميين الأتراك – مدارس دينية أو جماعات سياسية – فإن الانتماء للعنصر التركي والوطن عندهم هو صنو للفكرة الإسلامية في كيانهم، لا فرق بينهما، فهم يخدمون الإسلام في وطنهم ويخدمون وطنهم بالإسلام وثقتهم بالمواطن التركي صنوٌ لإيمانهم بدينهم، وبوصلتهم الفكرية والحركية لا تحيد عن هذا.
في حين يلحظ المراقب انسجاما كاملا في النفسية الإسلامية التركية بين الانتماء للدين والانتماء للوطن؛ يلحظ تنافرًا تامًّا بين هذين الانتماءين لدى الحركات والمدارس الإسلامية في البلدان العربية. وهذا ما يصنع فارقا كبيرا بينهما في موضوع الثبات داخل الوطن أو طبيعة الوعي السياسي.
إن الجهد الفكري لدى الحركات الإسلامية العربية موزع على الأمة كلها، ففكرها في قضية البوسنة، وأفغانستان، وتركستان وفلسطين، كفكرها في قضيتها الإسلامية داخل وطنها، بل لا يبالغ الإنسان إن قال: إن هم الواحد من شباب هذه الحركات في مساعدة المسلم في الأوطان البعيدة أكبر بكثير من همه في وطنه الذي ولد فيه، وهذا ما يُفقده عنصر الثبات ضمن الإشكالية الخاصة التي ينبغي أن يواجهها داخل موطنه والتي تقتضي منه مزيدًا من التركيز عليها. فهو عندما يشعر بالتضييق في وطنه بكل بساطة يحزم حقائبه ويهاجر بفكره إلى بلد آخر باحثًا له عن مجتمع جديد يحمل أفكاره، أو باحثًا عن دولة يحكمها نظام يتفق مع فكره، فيهاجر إليه ويدخل في خدمته، بل قد يزيد في التعصب له على ما عليه حال مؤسسيه، وفي تركيا نماذج كثيرة من أبناء الجماعات الإسلامية العربية التي تتعصب لحزب العدالة أكثر مما يفعل أعضاء الحزب الذين يناقشون تحركات حزبهم وفق النتائج لا وفق العواطف.
وما تفعله الجماعات الإسلامية العربية في الخارج؛ صورة مطابقة لما يفعله أبناء الحركات العلمانية عندما يتواجهون مع السلطة أو مع المجتمع فينتقلون للعيش في أوروبا أو أمريكا، ويصبحون أمريكيين أو أوربيين أكثر من أبناء البلد ذاته، وقد يحملون من العداء لأمتهم ما لا تجده في أبناء الحضارة الغربية.
الرهبنة السياسية:
إن أبناء الجماعات الإسلامية العربية التي نتحدث عنها لا تنقصهم الشجاعة في التضحية بأنفسهم، ولكنهم يفتقدون الثبات ولهذا ترك الكثير منهم وطنه ليذهب ويضحي بروحه وماله في أفغانستان أو الشيشان. وهذه مشكلة فكرية لا عقائدية أستطيع أن أسميها (الرهبانية السياسية)، لشبهها الشديد بالرهبانية النصرانية، إذ إن سلوك الإسلاميين العرب – المشارقة بالدرجة الأولى – في التخلي عن انتمائهم الاجتماعي لصالح ما يرون أنه انتماء للدين يشبه كثيرًا سلوك الرهبان النصارى بعد السيد المسيح عليه السلام الذين تخلوا عن انتمائهم الجسدي الإنساني تمامًا لصالح انتمائهم الروحي.
إن الرهبانية السياسية التي تعيشها مجتمعاتنا العربية اليوم نوع من المثالية التي لا تبني مجتمعًا ولا تقيم أمة، إذ لا بد للدولة حتى تقوم من العصبية كما أكد ابن خلدون، وإذا كانت عصبية القرون السابقة هي العشيرة فإن عصبية العصر الحديث هي الوطن، ووجود هذه العصبية جنبًا إلى جنب مع العقيدة هو ما يمنح الإنسان القدرة على الثبات والمواجهة، والقدرة على بناء الدولة. وفقدان هذه العصبية – كما هو حاصل – يعني عدم قدرة هذه الجماعات على الحكم، ويعني أيضا إمكان الانحياز إلى عصبيات فئوية أو إقليمية أقلّوية.
أثر نشأة الحركات الإسلامية في ثباتها:
إن المراقب لأحوال الجماعات الإسلامية في شتى البلدان الإسلامية يلحظ بينها فرقا أساسيا دفع بعضها للثبات وبعضها الآخر للهجرة، وهذا الفرق هو ظروف النشأة، فما نشأ وفق ظروف وطنية خاصة وبهدف معالجة ظروف مجتمع خاص كان أقدر على الثبات والإنتاج ممن نشأ امتدادا لتيار فكري إسلامي عالمي عابر للدول أو القارات، بالرغم من تقارب المنطلقات الفكرية التي انطلق منها كلا الفريقين.
قوة الانتماء العربي في صدر الإسلام:
لقد جاء الإسلام دين هداية لجميع الأمم على ما هي عليه من تمايز طبيعي وفطري، ولم يأت ليزيل الفوارق الطبيعية بينهم، وقد جمع القرآن الانتماء للدين والقوم والوطن في آية واحدة فقال الله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ». ونتيجة لهذا كان الوجود العربي واضحًا تمام الوضوح في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؛ كوضوح عالمية دعوته، فأبقى على النظام الاجتماعي كما هو؛ قريش سيدة العرب ولا تتساوى بغيرها، والأنصار إخوتهم الأقربون، وهو ينتمي إليهما معًا، ولا ينتمي لكل العرب داخل الدولة، لهذا أعلن للعرب قائلًا: «من يُرِدْ هوانَ قريشٍ أهانَهُ اللهُ عزَّ وجلَّ» وقال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ لا تُعَلِّمُوا قُرَيْشًا وَتَعَلَّمُوا مِنْهَا فَإِنَّهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ»، وقال: «الأئمة من قريش»، وجاء القرآن مؤكدًا على المهاجرين والأنصار كأساس للدولة والدين، ولم يساوِ باقي العرب بهم.
ونتيجة للوضوح في الانتماء لكل من الدين والقوم بقيت شخصية النبي الاجتماعية مرتبطة بالمهاجرين والأنصار ولم يحاول أبدًا أن يكون انتماؤه للشام أو اليمن أو العجم كانتمائه لعُصبةِ دينِه ومجتمعه. وفي الإطار الأوسع لم يخرجه انتماؤه لعالمية الإسلام عن الانتماء إلى العرب كعنصر يؤمن به وبقدراته فمدحهم وأشاد بهم وقال عن ذي قار: «هَذَا أَوَّلُ يَوْمٍ انْتَصَفَتِ الْعَرَبُ مِنَ الْعَجَمِ»، وقال: «إن الله حين خلق الخلق بعث جبريل، فقسم الناس قسمين، فقسم العرب قسمًا، وقسم العجم قسمًا، وكانت خيرة الله في العرب».
وهذا النهج هو ما سارت عليه الخلافة الراشدة والأموية فاعتمدوا الانتماء للعرب “عصبةً مركزية” في إدارة الدولة فانتشر الإسلام وخدموا بني قومهم وخدموا أبناء الشعوب الأخرى.. واستمر العرب في خدمة أنفسهم وغيرهم حتى تحولوا إلى الرهبنة السياسية في العصر العباسي الثاني استجابة لضغط الشعوبية وساووا أنفسهم بغيرهم فدالت دولة الإسلام ودولتهم، حتى تولى أمرَ الأمة شعوبٌ أخرى كانت تنتمي لأعراقها أو مجتمعاتها كانتمائها للإسلام كان من أبرزهم السلاجقة والأيوبيون والعثمانيون.
وقد تأثر الفقهاء عربًا وعجمًا بالتعاليم الإسلامية في ذلك، فلم يساووا بين العرب وغيرهم فيما يدخل العرق فيه كأحكام التكافؤ في الزواج والاسترقاق والعبيد. ولم يكن ذلك تعصبًا، ولكن باعتبار الفطرة الإنسانية فبنوا دولة استظلت بها الأمم قرونًا.. وعلى الجهة المقابلة عمل الفرس على صياغة مفهومٍ دينيٍّ محرَّفٍ خاصٍّ بهم يعينهم على إقامة دولتهم القومية في ظل انعدام ما يشير إلى أفضليتهم فنشأت دولتهم الرافضية بشكلها الذي استمرت عليه حتى اليوم.
مقارنة بين الأمويين والعباسيين والعثمانيين:
وعلى ما كان عليه الأمر في الدولة الإسلامية الأولى استمر بنو أمية منذ قيام دولتهم حتى سقوطها، وإن كانوا قد بالغوا في التعصب والظلم فهذا مما لم يحمد فيهم. لقد كانت الدولة الأموية دولة عربية ولهذا قامت كدولة وسقطت كدولة… وكذلك استمرت دولتهم في الأندلس حتى سقطت بيد الموالي.
أما العباسيون فقد كانت خلافتهم على قوة وضعف بمقدار ما وازنوا بين الانتماء للدين والانتماء الفطري للعصبية الاجتماعية، فبمقدار ما كانوا يشعرون بمركزيتهم كانوا قادرين على القيام بأمور الأمة، وبمقدار ما كانوا يفقدون إحساسهم بمركزيتهم كانوا يَذِلُّون ويعرضون دولة الخلافة والأمة للخطر. وقد بلغ الأمر بهم أن صعد البرمكي على ظهر الخليفة هارون ليقطف تفاحة، ولكنه تنبه فتدارك الأمر قبل فواته، وعندما غفل أحفاد الرشيد، وأدخلوا كل حابل ونابل وساوَوا أركان الدولة برعاعها الذين شُروا بالمال أو الذين لا يعرفون حرمة الأمة وتخلوا عن العصبية كأساس للحكم؛ غدا الخليفة ألعوبة بيد مماليكه، يطول عمره أو يقصر بمقدار ما يلتزم بكلام وزيره التركي أو الديلمي أو البويهي.
وعلى خلاف ما انتهت عليه الخلافة العباسية؛ نشأت السلطنة العثمانيين فقد كان إطار دولتهم التركي العثماني واضحًا ولهذا حافظوا على سلطانهم قرونا حتى سقط مرة واحدة ولم يسمحوا لحدودهم الاجتماعية أن تتحطم تحت فكر الرهبنة السياسية، ولو أنهم جنحوا إلى المثالية وترهبنوا لسقطت دولتهم منذ البداية وسقطت الأمة بسقوطهم. وما فعله العثمانيون يشبه كان عليه الأمويون، وهو وإن كان صحيحا سياسيا، إلا أنه لا يبرر ما وقع من مظالم واستعلاء وبغي من بعض ولاة الدولتين.
خلاصة الكلام:
إن الجماعات الإسلامية في البلدان العربية تحتاج إلى تأطير حقيقي للانتماء الاجتماعي القومي أو الوطني ليسير جنبًا إلى جنب مع الانتماء للإسلام، وبدون هذا التأطير ستبقى البوصلة ضائعة تدور في الجهات الأربع، وفي الثورة السورية شخصان مثَّلا أنموذجًا واضحًا وبسيطًا لهذه الأطروحة هما عبد الباسط الساروت، وعبد القادر الصالح، كلاهما كان من أبناء التيارات الإسلامية والوطنية على السواء، كانت بوصلة القائد عبد القادر والجندي الساروت دائمًا تشير إلى أهداف واضحة ومحددة، رفع الظلم وخدمة الوطن والشعب في سوريا حصرًا فاجتمع فيهما الانتماء للإسلام كأمة والانتماء للوطن والشعب، ولو أسلموا أنفسهم إلى أصحاب الإيديولوجيات لكانوا جزءا من نظام الفرقة الذي يحكم الساحة السورية، ولكنهما ترفّعا عن ذلك فطرة.
إن هذا الواقع الذي يطرحه المقال ليس خاصًا بالحركات الإسلامية في بلداننا فعلى الجهة المقابلة تعاني التيارات الليبرالية العربية المرض ذاته فلا تزال أفواجهم تهاجر نحو الغرب باحثة عن مجتمع حداثي تنتمي إليه.
وخلاصة القول: دون تضييق الهدف وتأطير مساحات العمل الإسلامي العربي وتحديدها ستبقى الهجرة العربية مستمرة في سبيل البحث عن مجتمع أو وطن مستأجَر، وستبقى الأوطان والشعوب لحكم العسكر وسلطة الأنظمة الرجعية.