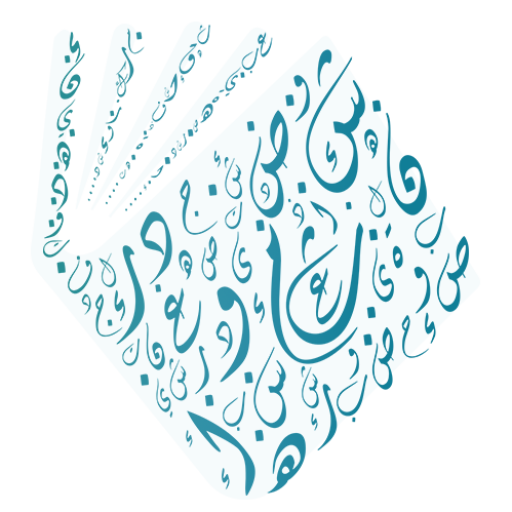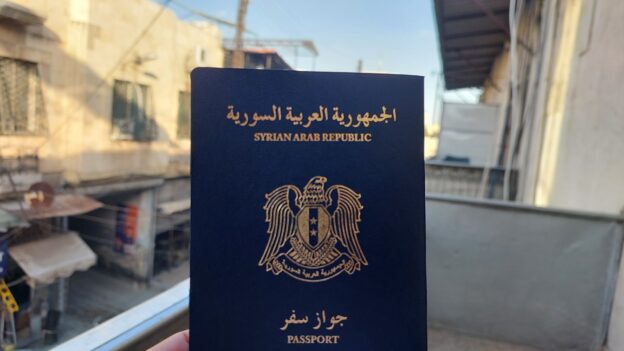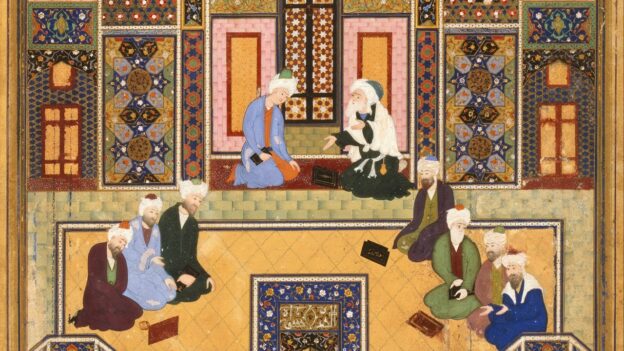[ المقالة ]
غزة وسوريا.. اختر طريقك بين الانفعال والفاعلية

لم يكن بين استيقاظ الضمائر، وتصحيح السرديات السائدة، واشتعال الحماسة، والتعلق بالأمل، وبين الاحتراق العاطفي، والشعور بالحيرة، وباللاجدوى، ولربما باليأس، وتغول التساؤلات التي تنم عن رغبة محمومة في معرفة ما يجب فعله، لئلا تتحول المشاعر والمواقف التي نعيشها إلى رد فعل عاطفي عابر؛ سوى تقلب الأحداث في غزة بين مد وجزر، وبين تصعيد وعنجهية، وقصف، ومجازر، وإصرار على حرب ضروس أكلت الأخضر واليابس.
ولم يكن بين الحزن والأسى والوجع الدفين، وبين استعادة الأمل والرجاء والأحلام المنسية، سوى سقوط نظام الأسد، وانتهاء عهده البائد، واستعداد الشعب السوري لاحتضان وطنه، وإعادة إعماره.
نحزن، نفرح، نغضب، نتفاءل، نشارك، نغرد، ندعو، نبكي حزنا أحيانا، وأحيانا من شدة الفرح.. لكن شيئا من هذا لن يقلب المعادلة.. لن يعمر أرضا، ولن يبني وطنا، ولن يوقف فاجعة، ولن يثني الموت المعربد عن تفننه في قطف الأبرياء.
هل هذا كل ما نملكه؟
هل هذا الذي سيعيد الحياة إلى الشهداء، والأمان إلى الأطفال، والبسمة إلى الوجوه الكالحة؟
هل هذا الذي سيبني سدا، ويُعبِّد طريقا، ويعيد للحارات عبق الياسمين؟
هل كتب علينا أن نبقى أسارى الانفعال دون قدرة على بلوغ عتبة الفاعلية الواعية المجزية؟
ماذا بعد الشعور؟
صحيح أن كل ما عشناه منذ السابع من أكتوبر، وبعده بسقوط نظام الأسد، وبشكل خاص، يشهد أن ما نعايشه هو تخلق لأحوال وأوضاع مختلفة بشكل جذري وعميق عن كل الأحداث السابقة، فهل يكفي، أمام هذه المسلَّمة، أن ننفعل مع واقعنا، وأن نتكيف معه؟ أم أن دورنا يتجاوز الانفعال العاطفي إلى أن نكون صناعا لهذا الواقع، فاهمين فهما صحيحا للمخاطر والتحديات التي تعرفها أمتنا، من أجل مواجهتها ومحاولة إيجاد حلول لأزماتها وفقا لمتطلباتها، آخذين بزمام مبادرة التغيير؟
ما التغيير الذي يفرض نفسه؟
ما الذي عليّ فعله عمليا كي أؤدي دوري في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، وفي وقف هذه المجازر أو في الإعمار؟
لعل أول خطوة على درب التغيير؛ أن نؤسس لفهم شامل يربط بين الوعي الذاتي الذي يتجاوز التفكر العابر المؤقت والعاطفة اللحظية؛ إلى استشعار المسؤولية، وبين تذكير النفس بأهدافها الكبرى، وبين مخططات ومشاريع لترجمتها إلى خطوات عملية، بحيث يصبح هذا الوعي الذاتي جزءا من حياتنا اليومية، وتصبح تحركاتنا وقراراتنا ومواقفنا نابعة من فهم أعمق للواقع الذي نعيش فيه، ومرتبطة ارتباطا مباشرا بمنظومتنا القيمية، وبالفهم العميق واليقيني للمسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه أنفسنا وأمتنا، وبأهدافنا الكبرى التي لا تعدو أن تكون عبادة، وأداء لأمانة الاستخلاف، فيشمل هذا الفهم بذلك الجانب الروحي، والعقلاني، والعملي، ويتجاوز التفاعل مع الحدث أو الاندفاع العاطفي، إلى “رؤية استراتيجية” تُبنى على أسس عقائدية وتوجيهات ربانية، تتماشى مع الواقع، ومع الحياة اليومية في جميع جوانبها، ويربط الفكرة التي هي الأساس العقلي الذي يجعلنا نفهم الحدث أو القضية بشكل أعمق، بالشعور الذي هو استجابة عاطفية للحدث، فنمنحه بذلك معنى أوسع وأعمق يوجه سلوكنا نحو الفعل المستمر. فالإنسان الواعي هو الذي يتجاوز الانفعال، فيلتقط الحدث، ثم يبني عليه فعلا مستقلا.
استشعار المسؤولية دون ترجمتها إلى خطوات عملية، وإلى دافع حقيقي للعمل، قد يجعلها تتحول إلى جلد للذات، وإلى يأس وإحباط، وإلى حيرة واضطراب وتشتت، ولربما أوصلت صاحبها إلى التشكيك فيما يحصل، أو إلى الاستقالة من متابعة الأحداث، والتملص من المسؤولية؛ تخفيفا من وخزة الضمير. فهذه المشاعر المتأججة لا بد أن نستثمرها، وأن نستثمر فوْرتها لأجل تصميم واضح، وعزيمة نافذة على المشاركة الفعالة، فنصوغ رؤية شخصية تجمع بين التفاؤل الذي لا يتعالى على الواقع، والواقعية التي لا تجر إلى اليأس، والاستمرارية التي تحول الأفعال المكرورة، وإن كانت صغيرة، إلى مشروع ثابت، وإلى مبادئ نعيشها، وتجعل المواقف الصغيرة تُحدث فارقا ولو على المدى البعيد، لكن من غير تحميل النفس ما لا تستطيعه، فنحن نحاسَب على قدر قدرتنا على إحداث التغيير، ولا تكلف نفس إلا ما لها فيه من وسع.
المبادرات الفردية مهمة، لكن العمل الجماعي أكثر نجاعة لاحتضان الفكرة، وللمساعدة على تجاوز “التفاعل اللحظي” إلى تنظيم وتحقيق أهداف عملية ملموسة. بمعنى آخر، نحتاج إلى العمل مع أفراد آخرين يشاركوننا نفس الحرقة، ونفس الأهداف، ونفس السعي لخلق فرق عمل أو مشاريع مستمرة تهدف إلى إحداث تغيير حقيقي، وتشد الأزر، وتذكر إذا ما كان التقصير، وتشجع على إعادة تقييم أنفسنا باستمرار، وتحفز على إعادة إشعال الحماسة والتصميم من جديد عبر وقفات نراجع فيها سعينا ونوايانا وأهدافنا.
ولكي نتقدم أكثر في هذا النقاش، دعونا نقف مع بعض المقترحات العملية لمشاريع فردية أو جماعية ترد على هذه الأسئلة، وتحول الشعور إلى فكرة وإلى سلوك:
“ماذا سأفعل لخدمة قضايا أمتي؟”
“كيف أُنمّي وعيي ووعي من حولي؟”
“ما المشروع الذي أستطيع أن أستهل به – ولو صغيرا – ويكون لبنة في البناء؟”
من الشعور إلى وعي فاعل:
1-غيرة وحماسة لا تخبو:
فأنا شاهد على الحق، حامل لهمّ الأمة، غيرتي وحماستي ودفاعي عن الحق تزداد حكمةً وفاعلية مهما كانت الأحداث، ولا تخبو مع التقادم أو مع تغير النتائج.
2-قلب مربوط بالعقل: مشاعري ليست تفاعلا لحظيا، ولا فورة عابرة، وإنما تنطلق من وعي ديني وفكري وفهم للواقع ولقوانين الحياة وسنن التدافع.
ثبات واستمرارية: كلما شعرت بفتور أو كلما هجم عليّ السؤال المحموم عن جدوى ما أفعله؛ أذكر نفسي بأنه غير مطلوب مني أن أغير العالم، ولا أن أسجل اسمي في دفتر جينيس للأرقام القياسية، وإنما أن أثبت على الحق، وأن أحيي سنة “النية الصادقة، وعمل قليل دائم خير من كثير متروك”.
3-وعي بالواقع:
-قراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم (من زاوية القيادة والنهوض بالأمة).
– اختيار سورة من القرآن وقراءة تفسيرها التربوي (مثل سورة الأنفال أو الأحزاب).
-متابعة محتوى هادف بطرح موضوعي ومتزن لشرح ما يحصل حولنا، أو للحديث عن أحد رموز النهضة الإسلامية
4-تجسيد نصرة قضايا أمتي في العمل اليومي (السلوك):
-دعاء دائم بنيّة النصرة
-إعانات وتبرعات مادية
-مشاركة محتوى توعوي على وسائط التواصل (نقل الوعي، لا نقل الوجع فقط).
-مقاطعة منتجات تدعم الاحتلال
-تربية النفس على الصبر والثبات
-مراجعة النية عند كل موقف
5-التأثير المجتمعي (نقل الرسالة):
-الإسهام في بثّ هذا الوعي في محيطك الصغير: (العائلة، الأصدقاء، المدرسة، العمل…)
-فتح نقاشات هادئة مع من حولك عن قضايا الأمة من منظور العقيدة وسنن التغيير.
-تصميم نشاط فكري مع أصدقائك أو أطفالك (جلسة قراءة ومناقشة لكتاب عن القضية).
-إن كنت ذا قلم، تسجيل صوتيات قصيرة أو كتابة مقالات أو منشورات من القلب.
-إن كنت من الفاعلين، تنظيم لقاءات دورية مباشرة أو عن بعد لمدارسة قضية أو تعلم مهارة.
نعود لنتساءل: هل رددنا فعلا على سؤالنا المشروع، النازف من جرحنا المفتوح، ومن إحساسنا بالعجز، وبالغضب المكبوت من كثرة المبادرات وقلة النتائج:
كيف لهذه المشاريع أن تعيد إعمار بلد، أو أن توقف شلالات الدماء بشكل فوري؟
نريد حلا عمليا وليس مشروعا شخصيا. نريد أثرا واقعيا، لا تنظير وخطب عنترية..
من الطبيعي أن نشعر بالمرارة والألم بسبب أوضاع أمتنا، وأن نبحث عن حلول ملموسة وواقعية. وسيكون من الكذب والتضليل أن نقول إن المقترحات آنفة الذكر تعمل بشكل مباشر على إيقاف هذا الجرح النازف، أو لها كفل من إعادة الإعمار، لكن استهلالنا الحديث في هذه المقالة عن الوعي كان لأجل التأصيل للرد على مثل هذا السؤال، فهل من الممكن أن يكون الحل في الجهود الفردية أو حتى الجماعية من القاعدة أي من المواطنين والأفراد؟ الرد سيكون تفصيليا، فواقع غزة ليس هو واقع سورية، وبالتالي فالرد على هذا السؤال سيكون:
-“نعم” قولا واحدا فيما يخص سورية. فالشعب السوري أمام فرصة تاريخية نادرة لإعادة بناء وطنه على أسس جديدة، وبلده في حاجة، بل يستحق منه أن يعيد له البسمة بعد عقود من الظلم والحيف والخراب، وهذا البناء والإعمار المأمول يدخل في حيز المستطاع والمقدور عليه من لدن الأفراد إلى جانب الحكومة، إذ يكفيهم أن يتبنوا مشاريع إنمائية بتخطيطات استراتيجية كي يستطيعوا المضي في بناء سورية الجديدة.
– “لا” بدون تورية ولا مماراة أو فذلكة أو مثالية متعالية منقطعة عن الواقع بخصوص ما يحصل في غزة، فواقع غزة ليس هو واقع سورية، وما من شأنه أن يوقف الإبادة هناك ليس هو ما يعول عليه لأجل إعادة الإعمار هنا، إذ وقف النار رهين بحاملها، أو بإعداد مكافئ وعدة تجعل كفة النصر راجحة، في حين أن بناء النهضة رهين بالواثق من أن الإعمار يقوم على أكتاف الشباب، وعلى المبادرات الفردية والجماعية المُسهمة في إعادة ترميم ما انهار.
لكن الذي نراهن عليه؛ أن ينبع التغيير من زيادة الوعي بقضايا الأمة، وبالتفاعل الفردي الذي من الممكن أن يحدث تأثيرا تدريجيا. فمشاريع مثل ما أشرنا إليه لا تهدف إلى حل الأزمة بشكل مباشر، بل تهدف إلى الوعي الذاتي، وإلى نشر الوعي والتأثير على الرأي العام، مما يمكن أن يؤدي في النهاية إلى ضغط دولي أكبر على القوى السياسية لاتخاذ إجراءات حقيقية، ويدفع الدول والمنظمات، والجمعيات، بل حتى الأفراد إلى تقديم الدعم المادي والسياسي للشعوب المنكوبة أو التي عادت فيها الحياة من جديد بعد سقوط الأنظمة الفاشية، وتسعى لإعادة إعمار بلدانها. نحن بحاجة إلى أن نكون جزءا من موجة من الوعي التي تفتح العيون وتؤثر في المسؤولين، وأن يكون للتضامن الشعبي دور محوري في تحفيز التغيير، وفي الدعم القانوني وتوثيق الانتهاكات، مما يساعد في خلق مواقف قانونية دولية تطالب بتحقيق العدالة ضد الجرائم المرتكبة بحق الشعوب والضغط الدولي للمحاسبة.
بالإضافة إلى التوعية، المساعدات المالية والتبرعات يمكن أن تخفف قليلا من المعاناة، وهذا يمكن أن يكون جزءا من الحل، حتى لو كان على المدى القصير.
مبدئيا، التغيير يبدأ من الداخل، هذه قناعتي، وهذا ما أراه حلا لكيلا نمضي حياتنا ننتظر الحلول الجاهزة، فالتغيير لا يأتي إلا عندما يشعر الناس بضرورته، وبقدرتهم على التأثير، والمشاركة الفاعلة في بناء مشاريع إغاثية وتوعوية تبث الأمل، وتعلم الأمة كيف يمكن أن تكون أكثر وحدة وتعاونا في مواجهة الأزمات، وتؤسس لمستقبل أفضل.
عن أي تغيير أو فاعلية إذن هذا الحديث ونحن لن نستطيع أن نرى النتائج؟ أليس الأمر مدعاة لليأس، وللكفر بكل مبادرة من هذا القبيل، وللتوقف عن كل شيء ما دامت الحلول المستعجلة متعذرة الآن لأجل وقف النزيف؟
من القلب إلى القلب:
أعلم أن هذا المقال لم يأت بالجديد، وأعلم أن ما اقترحناه فيه، وما نفعله، لا ينسف دبابة، ولا يوقف صاروخا، ولا يعيد شهيدا، ولا ينتزع طفلًا من تحت الأنقاض، وأعلم أن الجميع يريد حلا فوريا يغير الواقع الآن الآن، وليس على المدى البعيد، لكن دعونا نتساءل: متى بدأت هذه المأساة؟ هل بدأت مع الطوفان؟ أم حين تبرأت الأمة من هويتها، وتراجعت عن وحدتها، وعن فهم قضاياها وحملها؟
صحيح أن هذه المقترحات قد تبدو مشاريع شخصية، والحلول التي تقدمها ربما لا تحل الأزمة الحالية بشكل فوري، ولكن الاستمرار في العمل على المدى الطويل هو ما يحقق الفارق، إذ لا يوجد حل سحري لحل الأزمة، فالمعركة ما زالت طويلة، وواهم من يظن أنها ستحل بالأماني، وبالتوقعات المثالية، والهدف الأسمى من هذه المبادرات أن نحاول من خلالها أن نعيد بناء الأمة. فغزة لا تحتاج فقط إلى خبز ودواء، ولا إلى وقف مؤقت للنار، وإنما إلى أمة حية، لا تنام كلما هدأ القصف. تحتاج إلى من يزرع في القلوب وعيا، وفي العقول فهما، وفي السلوك التزاما. تحتاج إلى أمة تفهم فهما عميقا ما يدور حولها، وإلى الإعداد المكافئ، والتفكير الاستراتيجي، وفهم قوانين الحياة، وسنن التدافع، وموازين القوى لعله يخرج من أصلابنا من يمسح عنا عار الهزائم، ويكتب التاريخ عوض أن يكتفي بقراءته.
وماذا عن المشاريع العملية الممكنة، تلك التي تخص سورية؟
لعل أول ما يجب الحديث عنه ونحن نتحدث عن صناعة التغيير في سورية، أن ننصح الشباب بالتسلح بالعلم والمعرفة والاستثمار في الذات واستثمار الخبرة التي تكونت لديهم في بلدان النزوح. المهارات العملية مثل الطب، والهندسة، والإدارة، والتعليم، والزراعة وغيرها ستجعل الشباب أدوات حقيقية في إعادة الإعمار، والذي لا يتأتى إلا بتشكيل وعي سياسي ناضج، وبالمشاركة في المجتمع المدني من خلال تأسيس جمعيات، ومبادرات تطوعية، وفرق إغاثة وتنمية، ومراكز ثقافية،…فالمجتمعات لا تُبنى فقط بالحكومات، بل بالمجتمع المدني القوي، القائم على التمسك بالقيم الإسلامية، وعلى إعادة صياغة هويته، من جهة كهوية جامعة باعتبار التعددية الدينية والطائفية التي تكونه، ومن جهة باعتبار الحمولة الثقافية التي عاد بها من بلد النزوح، وما لها من تأثير على أفكاره ومعتقداته وممارساته.
البدء من القاعدة سيكون مهما في هذه المرحلة، وذلك من خلال توفير الخدمات الأساسية، وتنظيم الأمور الحياتية بشكل جماعي سواء في الأحياء أو القرى أو المدن، وبهذا وبغيره سيكون السوري قد حدد طريقه بين الانفعال والفاعلية، فكان أن اختار أن يكون صاحب قرار، وصاحب فعل، وأن يكون متفاعلا عوض أن يظل منفعلا.